 |
| جديد المواضيع |

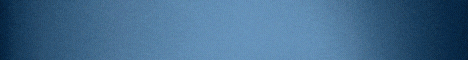
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
| منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
ظهور البدع في المسلمين، وأسبابها، وأضرارها، والبدع في مجال العقائد، وبدعة الخوارج والتشيع
عناصر الدرس العنصر الأول : وقت ظهور البدع ومكانها العنصر الثاني : أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور البدع العنصر الثالث : آثار انتشار البدع العنصر الرابع : بيان المذهب الصحيح في العقيدة العنصر الخامس : بدعة الخوارج العنصر السادس : بدعة التشيع أ- وقت ظهور البدع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله، تبارك وتعالى-: "واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، كما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حيث قال: ((مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين))، وأول بدعة ظهرت هي بدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والخوارج، ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وذلك في أواخر عصر ابن عباس وابن عمر وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبًا من ذلك. وأما الجهمية: فحدثت في أواخر عصر التابعين، بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وهذه البدع ظهرت في القرن الثاني الهجري، وكان الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- قد شاهدوا بعض هذه البدع كبدعة: الخوارج، والروافض، والقدرية، وكان الصحابة عند ظهور هذه البدع منكرين على أهلها، ثم لما ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف، وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة؛ قام أيضًا أهل العلم بالرد وبيان بدع هؤلاء. والشاهد من هذا: أن هناك بدعًا ظهرت في حياة الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- ولكن بعد مرور هذا الزمن من عهد الصحابة؛ ظهرت بدع أخرى كثيرة؛ منها: بدع التصوف، والبناء على القبور، وهذه البدع كانت من البدع الشديدة التي عمت كثيرًا من بلاد المسلمين، وكان لها من الآثار السيئة التي ندعو عموم المسلمين أن لا يقعوا فيها، وأن يرتفعوا بأنفسهم عنها. ب- مكان ظهور البدع: تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن الأمصار الكبار التي سكنها صحابة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وخرج منها العلم والإيمان خمسةٌ: الحرمان، والعراقان، والشام. ومنها خرج القرآن، والحديث، والفقه، والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدعٌ أصولية غير المدينة النبوية، والكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر، وأما التجهم فظهر في ناحية خراسان، وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البدع عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- ظهرت بدعة الحرورية، وأما المدينة المنورة: فكانت سليمة من ظهور البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكنهم كانوا مقهورين أذلاء، وذلك بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك في البصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرًا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن الدجال لا يدخلها، ولم يزل العلم والإيمان ظاهرًا في مدينة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى زمن أصحاب مالك، وكان أصحاب مالك متوافرين ولهم تلاميذ استمروا في المدينة النبوية، وأما العصور المفضلة الثلاثة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين ألبتة كما خرج من سائر الأمصار. مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه النجاة من الوقوع في البدع والضلال، وقد قال الله تعالى: {چ چ چ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [الأنعام: 153]، فمن أعرض عن الكتاب والسنة فنازعته الطرق المضلة والبدع المحدثة. وهناك أسباب متعددة أدت إلى ظهور البدع في المسلمين وهي مهمة، ولا بد من ذكر أهم الأسباب حتى ولو كانت كثيرة؛ ليحذر الناس هذه الأسباب حتى لا يقعوا في البدع والضلالات. السبب الأول: الجهل بأحكام الدين: كلما بعد الناس عن آثار الرسالة، وكلما امتد الزمن قلّ العلم وفشي الجهل، كما أخبر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله: ((مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا))، وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))، وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يكون في آخر أمتي أناسٌ دجَّالُونَ كذابون، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم)) وقال تعالى: {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [الأعراف: 33]، وقال تعالى: {ﮆ ﮇ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} [الأنعام: 144]. وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَن أفتى بغير علمٍ كان إثمه على مَن أفتاه))، والقول في الدين بغير علم يضلِّلُ الناس؛ ويكون إثم مَن وقع في الضلال على مَن كان هو السبب في الضلالة. السبب الثاني: الجهل بمصادر الأحكام، أو الجهل بوسائل فهمها من تلك المصادر: إن مصادر الأحكام الشرعية -كما هو معلوم- كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- وما أُلْحِقَ بهما من الإجماع والقياس، بمعنى: أنه يؤخذ الحكم من كتاب الله تعالى وتليه السنة، ثم الإجماع والقياس، والقياس لا يُرجع إليه في أحكام العبادات؛ لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولًا، بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض، وإذا كان القياس لا يدخل في العبادات فمن أولى لا يدخل في العقائد. ومن أسباب الجهل بالأحكام: الجهل بأساليب اللغة العربية، والجهل بالسنّة، والجهل بمرتبة القياس والجهل بمحل القياس، وسأتكلم عن كل نقطة من هذه النقطة بيسير من الكلام. أما الجهل بأساليب اللغة العربية: فقد نجم عن هذا الجهل أن فهمت بعض النصوص على غير وجهها، مما كان سببًا في إحداث ما لم يعرفه الأولون ومن ذلك ما يزعمه البعض من أن المحرم من الخنزير هو لحمه فقط دون شحمه؛ أخذًا من أن القرآن الكريم حرَّمَ اللحم فقط، وهو ابتداع نشأ من الجهل بأن كلمة "اللحم" في اللغة العربية تطلق على الشحم دون العكس. وأيضًا من الجهل باللغة العربية الموقع في البدع، قول بعض الناس: أن حديث: ((إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي))، قال بعض الناس: بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يطلب من المؤذن عقب الأذان أن يؤذن هو عليه، وإن ذلك بالجهر كما يجهر بالآذن ولم يفهم هذا ولم يفهمه أحد من حديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بل إن الحديث يفيد: إنه وجب على مَن سمع الآذان أن يردد كلمات الآذان ثم يصلي في نهايته على النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد من العلم بلغة العرب، وقد أجمع أهل العلم على وجوب المعرفة بما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من خصائص اللغة العربية، وهو شرطٌ أساسيٌّ لمعرفة النصوص الشرعية والاقتراب منها. أيضًا الجهل بالسنة: الجهل بالأحاديث الصحيحة، والجهل بمكانة السنة من التشريع، هذا جهل بمصادر الأحكام يترتب عليه إهدار الأحكام التي صحت بها الأحاديث؛ ويترتب عليه أيضًا إهدار الأحاديث الصحيحة، وعدم الأخذ بها فتحلُّ مكانها بدع لا يشهد لها أصل من التشريع، وقد نبهنا إلى ذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد سبق أن ذكرت الحديث الذي أفاد فيه النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- من أن الله -عز وجل- لا يقبض العلم انتزاعًا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء خلف من بعدهم خلوف، كما أخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديثه: ((ما من نبي بعثه الله -عز وجل- في أمة، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)). قال ابن القيم -رحمه الله- هو يوضح أسباب وقوع بعض البدع في شرك القبور والأضرحة: فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها؛ مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. قيل: أوقعهم في ذلك أمور، منها: الجهل بحقيقة ما بعث به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بل جميع الرسل بعثوا بتحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، وهؤلاء الذين وقعوا في ذلك قلَّ نصيبهم جدًّا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما عندهم من العلم. كذلك الجهل بمرتبة القياس وبمحل القياس يجعل الإنسان في الحقيقة يجهل مصادر الأحكام الشرعية، أو يجهل الوسائل التي تفهم بها ومن خلالها هذه المصادر؛ وبالتالي يكون الجهل بمصادر الأحكام والجهل بوسائلها من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في البدعة وظهورها -والعياذ بالله تبارك وتعالى. السبب الثالث: اتباع الهوى في استنباط الأحكام: الهوى هو ميل عن الحق إلى رغبات النفس ومراداتها، وكما يكون في الشهوات يكون في الشبهات، وأصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه هو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه؛ فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، واتباع الهوى أصل كل شرع وأساس أي انحراف عن الصراط المستقيم فما من فتنة وقعت إلا كان من وراءها أهواء الأنفس وميلها إلى نيل شهوة تلائم طبعها، أو اتباع شهوة توافق عقلها. قال ابن القيم -رحمه الله-: إن الهوى ما خالط شيئًا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء من مخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدَّه عن الحق. وأما عن اتباع الهوى في استنباط الأحكام فإنه يأتي من أن الناظر في الأدلة قد يكون مما تملكهم الأهواء؛ فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به، وهذا الواقع يجعل الهوى أصلًا تحمل عليه الأدلة، ويحكم بها عليه؛ مما يؤدي إلى قلب قضية التشريع، وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة؛ لأن الأصل أن تؤخذ الأحكام من الأدلة لا أن تقرر الأحكام ثم تتصيد لها الأدلة، وهذا ما يفعله أهل الهوى والضلال. ومتابعة الهوى هي أصل الزيغ عن الصراط المستقيم، وذلك مصداق قول الحق -تبارك وتعالى-:{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [القصص: 50]، وقد حذر -صلى الله عليه وسلم- من اتباع الهوى في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن معاوية -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((... وأنه سيخرج من أمتي أقوام، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله))، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يخاف الأهواء ويتعوذ بالله منها قائلًا: ((اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء)) . وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)). السبب الرابع: إحسان الظن بالعقل في الشرعيات: الله -تبارك وتعالى- جعل للعقول حدًّا تنتهي في الإدراك إليه، ولم يجعل لها سبيلًا إلى إدراك كل شيء، ومن الأشياء: الشرعيات، وهذه الأمور لا يصل العقل إليها ولهذا كان لا بد من الرجوع إلى خبر الصادق، ما يلزم العقل بذلـك، وقد بينت هذا فيما مضى بشيء من التفصيل، وإشارتي هنا فقط لأبين من خلالها: أن إحسان الظن بالعقل وإعمال العقل في مسائل الدين أدى إلى وقوع البدع بين المسلمين، ورب العالمين سبحانه بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وكان خاتمهم -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي بعث ليبين للناس ما يرضي خالقهم، ويضمن سعادتهم ويجعل لهم حظًّا وافرًا من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك يجب علينا اتباع ما جاء في الشرع، أما من أحسن الظن بالعقل ورفعه إلى فوق مستواه، وحكمه فيما لا يدركه مما أنزل الله؛ فهؤلاء مبتدعة في الدين حينما رجعوا إلى العقل، ولقد أعانهم على هذا الابتداع في العبادات أنهم نظروا فيما أدركه العلماء من أسرار التشريع وحكمته وزعموا أن هذه الأسرار هي المقصودة لله في تشريع الحكم، وأنها هي الداعية إليه فشرعوا عبادات أخرى؛ تحصيلًا لمثل هذه الأسرار التي عهدت في بعض تشريع الله، وقد وقع كثير من الابتداع بهذه الطريقة،وبحكم العقل القاصد، زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشد الناس حرصًا على التقرب إلى الله، ومنها قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد، وقراءة الأدعية أمام الجنائز، وقد قال الله تعالى في وصف هؤلاء: {گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [الكهف: 103، 104]، وهذا النوع من الابتداع يأتي على نوعين: الأول: إلحاق غير المشروع بالمشروع؛ لأنه يزيد في المقصود من التشريع وذلك مثل التعبد بترك السحور؛ لأنه يضاعف من قهر النفس المقصود من مشروعية الصيام، ومثله التعبد بتحريم الزينة المباحة التي لم يحرمها الله لأنه يزيد في الحكمة المقصودة من تحريم الذهب والحرير، ومن هذا اختيار أشد الأمرين على النفس عند تعارض الروايات، مع أن المأثور عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه أثم، فإن كان فيه أثم كان أبعد الناس عنه)) -صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حمل بعض الناس أفعال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على التعبد الذي لا يجب فيه التأسي ولا طلب ذلك من هديه -صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني: اختيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع، كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج والتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات، وقد جاء التحذير من ذلك كله، ومنه قوله النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ما بالُ أقوامٍ يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم خشيةً له))، وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لن يشدّ الدين أحدًا إلا غلبه))، وقال أيضًا: ((لا تشددوا على أنفسكم؛ فيشدد الله عليكم)) كما رد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على ابن عمر والرهط الذين تقالُّوا عبادته -صلى الله عليه وآله وسلم- وأرادوا مشاق الطاعات. وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات واخترعوا لأنفسهم عبادات وكيفيات، أو التزامات خاصة، وعبدوا الله -تبارك وتعالى- بها، وعلموا أتباعهم على أنها دين، وجهلوا أن القرب من الله إنما يكون بالتزام تشريع الله وأحكامه، وأن وسائل التقرب إلى الله محصورة فيما شرعه، وبلغه عنه رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الخامس: اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء المبتدعين، وابتغاء تأويله من الجهلة المتعالمين: والأصل في بيان ذلك الآية التي سبق أن أشرت إليها، وهو قول الحق -تبارك وتعالى-: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ں ں ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [آل عمران: 7]، وتفيد الآية أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل هذه المتشابهات وأن ذم اتباع هذه المتشابهات عامٌّ يتناول الجاهل والعالم على السواء. ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه الحاكم بسنده عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس يقول: {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} ويقول: {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}، ومما لا شك فيه أن هناك أمور لا يعلمها إلا الله بنص القرآن والسنة الصحيحة، قال تعالى: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [المدثر: 31]، وقال سبحانه: {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ} [الشورى: 11]. ومذهب السلف: أن الصفات النقلية -كالاستواء واليد والنزول والضحك إلى آخره ونحو ذلك- صفات ثابتة وراء العقل ما كُلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه فيها؛ لئلا يضاد العقل النقل. والمذهب الصحيح في العقيدة هو ما ذهب إليه السلف الصالح مع عدم التأويل أو التعطيل أو التمثيل، وأنه سبحانه {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ}. أما الخلف: فقد ابتدعوا في هذه المسائل، وأولوا هذه الصفات؛ زاعمين أنها من المتشابه التي لا يُعرف معناه، ولكنها في الحقيقة هي من المتشابهة في الكيفية والحقيقة، أما في المعنى فهي معلومة على لغة العرب. ومن أمثلة البدع التي أدخلها علماء الكلام بحجة أن آيات الصفات من المتشابه الاستواء، قالوا في الاستواء بأن معناه الاستيلاء والغلبة، واليد تراد بها القدرة أو النعمة، وقالوا المراد بالوجه: الذات أو الرحمة، والعين: الإحاطة، وهؤلاء في الحقيقة قد جمعوا بين التشبيه والتعطيل. السبب السادس: انتشار الأحاديث الموضوعة والواهية: الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي روجها من انتسب إلى العلم أو الرواية، إما لقصد الإفساد في الدين كالزنادقة والملحدين، الرامين بذلك إلى الطعن في الدين، كما ذهبت الكرَّامية إلى تجويز الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترغيبًا وترهيبًا، وغلاة الشيعة وضعوا أحاديث في فضل آل بيت، وفي علي وخلافته، واستحقاقه للنبوة، وتلقيه للوصية من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما أن بعض المغفلين قصدوا الزيادة في التعبد في الدين، وذلك بأن وضعوا أحاديث في الوضع والرقائق ترغب الناس في مثل هذه المسائل. وأحب أن أنبه هنا إلى أن بعض الأحاديث الواهية والضعيفة بل الموضوعة قد وجدت في كتب الفقهاء الذين لا يستطيع البعض منهم أن يميز بين الصحيح أو السقيم، أو أن بعضهم كان يرى أنه لا حرج من إيراد الحديث بسنده، وطالما أنه أورد الحديث بسنده؛ فلا شيء عليه، ويكون بهذا قد خرج من عهدة البلاغ، وعلى الذي يريد أن يعرف صحة الحديث أن يبحث بعد ذلك في سلسلة الإسناد. والشاهد من كل ذلك: أن انتشار الأحاديث الضعيفة والباطلة والواهية والموضوعة كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور البدع في المسلمين؛ ولذلك أطالب أهل العلم ومن يكتبون في الدين أن يتحروا صدق ما يكتبون، أي: أن يتحروا كتابة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم. السبب السابع: التعصب لآراء الرجال: التعصب هو الإصرار على الرأي والتمسك به وتقديمه على النصوص الشرعية، وتمحل الأدلة وتكلفها لتأييده، وإن كان على خلاف الحق والصواب، وهو في ذاته بدعة ذميمة، بل هو من أمر الجاهلية المنتنة ومن شيم المغضوب عليهم الضالين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مَن تعصب لواحدٍ بعينِهِ من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة -رضي الله عنهم- وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي -رضي الله عنهم- فهذه طرق أهل البدع الذين ثبت من بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج، الذي بعث الله به رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء. وهذا التعصب يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، قال تعالى: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ چ چ چ ﭾ} [لقمان: 21]، وقال -جل جلاله-: {ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ} [النجم: 28]، وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض اتباع المذاهب الذين سلكوا طرقًا منحرفة كالصوفية والقبوريين فإنهم إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة وما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم، ومن أخطر العصبيات التعصب في الدعوة مبررة باسم الدين؛ فتجد أكثر الدعوات الإسلامية المعاصرة تعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على العلوم الشرعية والعلماء، ويتخذون في ذلك لهم أولياء يتبعونهم ويتعصبون لأقوالهم وآرائهم. السبب الثامن: التشبه بالكفار: ومن أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: ((خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وعندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: الله أكبر؛ إنها السنن، قلتم: ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ ٹ ٹ} [الأعراف: 138]، ثم قال: لتركبن سَنن من قبلكم...)) إلى آخر الحديث، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لتتّبعن سَنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟! قال: فمن)). ومن هذه الأحاديث: يتبين لنا أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وأن يجعل لهم شجرةً يتبركون بها من دون الله، وكانوا حديثي عهد بالإسلام، وهذا هو نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قد قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة، والاحتفال بالمناسبات الدينية، والذكريات، وإقامة التماثيل، والنصب التذكارية، وإقامة المآتم، والبناء على القبور، والتمسح بها، والطواف بها وغير ذلك. السبب التاسع: التأثير بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين: وفي هذا تجد أن كل فرقة في الإسلام قد استحدثت بعض أصولها وأكثرها من الملل السابقة؛ فالرافضة أخذت عن اليهود والمجوس والجهمية، والمعتزلة أخذوا عن الصابئة وفلاسفة اليونان والقدرية عن النصارى وهكذا، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لتتبعن سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُم)). قال ابن الجوزي -رحمه الله- ولما كانت الفلاسفة قريب من زمان شريعتنا والرهبنة كذلك مدَّ بعض أهل ملتنا إلى التمسك بهذا، وبعضه مد يده إلى التمسك بهذه؛ فترى كثير من الحمقى إذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا وإذا نظروا في باب الزهد ترهبنوا، فنسأل الله ثباتًا على ملتنا وسلامةً من عدونا. قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الأنبياء في العلم، ويقول: إن هارون كان أعلم من موسى، وإن عليًّا كان أعلم من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما يزعمون أن الخضر كان أعلم من موسى وأن عليًّا وهارون والخضر كانوا فلاسفة، يعلمون الحقائق العقلية أكثر من موسى وعيسى ومحمدٍ -عليهم السلام- لكن هؤلاء كانوا في القوة العلمية أكمل؛ ولهذا وضعوا الشرائع العلمية، وهؤلاء يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفلاطون القبطي، وغيرها من المقالات التي تقولها الملاحدة المتفلسفة المنتمون إلى الإسلام في الظاهر من متشيع ومتصوف كابن سبعين وابن عربي وأصحابه. كما أخذ أهل الأهواء والبدع عن ديانات أهل الكتاب من يهود ونصارى، ونِحَلِ المشركين والصابئة والمجوس والبراهمة، وتأثرت مذاهبهم بهذه الأديان الضالة المنحرفة وتلك الملل الباطلة المنحرفة. قال ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- في معرض نقده لنفاة الخلة والمحبة: وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة، والمتفلسفة، ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس لها صفة ثبوتية أصلًا, وهؤلاء هم أعداء الرسل -إبراهيم الخليل عليه السلام- وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلًا وموسى كليمًا. السبب العاشر: التسليم لغير المعصوم: فبعض الفرق لم تسلم للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فالشيعة مثلًا يقولون: إن الأئمة معصومون كالأنبياء عن الصغائر والكبائر، والمعصوم فقط في ملتنا هو نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- لأنه -عليه الصلاة والسلام- هو الذي لا ينطق عن الهوى، أما غيره من آحاد الناس فليسوا بمعصومين فهم يخطئون ويصيبون. قالت الشيعة: إن الأئمة عندهم لهم من العصمة، كما للأنبياء من العصمة، وفي ذلك يقول محمد الحسين الكاشف: إن الأمامية تعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- لا يخلي الأرض من حجة على العباد من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور، والإمامة منصب إلهي كالنبوة، وهم بذلك يخالفون النصوص، ويحاولون ما استطاعوا جرَّ الناس إليها وإجبارهم عليها، قال تعالى: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [التوبة: 31] وقد فعل ذلك الروافض. وقد سار القول بتقليد الإمام المعصوم والتسليم لكل ما يأتي به، واعتبار ما يأتي به أساسه لفهم النصوص عند كثير من الناس؛ فأهل الطرق الصوفية يعتقدون العصمة في مشايخهم، وينقلون البدع، بل والمعاصي عن شيوخهم على أنها شرع وقربة لله تعالى، بل ويدَّعُون بأنهم يحصلون العلم اللدني، أي: العلم الرباني، والغلو في تعظيم شيوخهم، وإلحاقهم وقولهم عليهم وفيهم بما لا يستحقون؛ أدى بهم إلى أن يخرجوا عن الشرع القويم الذي جاء به النبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب هذا الغلو في الدين، والتكالب على نصرة المذهب، والتهالك في محبة المبتدع والبدع دخلت فروع كثيرة في الشريعة ليس لها أصلٌ من كتاب الله، ولا من هدي رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه. أ- آثار انتشار البدع: انتشار البدع له آثار عامة وآثار خاصة. فمن الآثار العامة في انتشار البدع: زوال السنن وخفائها، وكثرة الخلاف والشقاق بين أفراد الأمة، وازدراء السنن وتنقيصها، وإلغاء حكم الشرع وتحكيم العقل، وتشويه معالم الدين، هذه هي الآثار العامة التي كانت وراء انتشار البدع. أما الآثار الخاصة -وهي أيضًا تأتي على صاحب البدعة وتضره-: أن عمل المبتدع مردود، وأن التوبة تحجب عنه، وأنه لا يرد حوض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه يدخل في عداد القائلين على الله بغير علم. ب- أضرار البدع: أضرار البدع إجمالًا: هذه النقطة أفردتها بالذكر لأهميتها ولا بد لكل عاقل أن يعرفها؛ لأن العاقل إذا عرف أضرار البدع، لا شك أنه سيقلع عنها ولن يأتي بها ولا يقع فيها؛ لأنه سيعلم أنها ضلال وانحراف وأنها ستضره في دينه، وستضيق عليه عندما يقف بين يدي ربه ومولاه. البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاةٍ ولا صيامٍ ولا صدقةٍ ولا غيرها من القربات، الذي يجالس صاحب البدعة ينزع الله -عز وجل- منه العصمة والماشي إليه، أي إلى صاحب البدعة، وموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحب البدعة فهي تجلب لعنة رب العالمين -سبحانه وتعالى- وتزيد العبد من ربه بعدًا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، وتمنع من الشفاعة المحمدية، كما أنها ترفع السنن التي تقابلها؛ فما ظهرت بدعة إلا وأزالت مكانها سنة كانت قائمة، والمبتدع عليه إثم من عمل ببدعته، ويُبعد عن حوض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أضرار البدع تفصيلًا: الضرر الأول: إدعاء حق التشريع للبشر، واتخاذهم أربابًا من دون الله -تبارك وتعالى- قال تعالى: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [التوبة: 31]، وقال سبحانه: {ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [النحل: 116]، وقال تعالى: {ھ ے ے ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [الشورى: 21]، فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله فقد أشرك بالله -تبارك وتعالى- وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة، قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). الضرر الثاني: الطعن في الدين، بالاعتقاد أن التشريع جاء ناقصًا، وأنه تكمله هذه البدعة، والله -عز وجل- قد أتم لنا الدين، وأكمل علينا نعمته قال تعالى: {چ چ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [المائدة: 3]. قال الإمام مالك -رحمه الله تبارك وتعالى-: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: {چ چ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [المائدة: 3]. وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: من استحسن فقد شرع، ولو جاز الاستحسان في الدين؛ لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج الإنسان كل يوم لنفسه شرعًا جديدًا، فإذا كان المبتدع يرى أن ابتداعه لم يكن إلا لخير الناس في دينهم فيجب عليه أن يشعر بالحزن العميق، والخوف من عذاب الله؛ لأنه يتهم الله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بعدم اكتمال الدين، وهذا لا شك أن هذا متبع لهواه والله -عز وجل- نعى على الذين يتبعون أهوائهم بغير علم. الضرر الثالث: التعبد لله بما لم يشرع؛ فيقوم إبليس بالتلبيس على الناس بحيث يعتقدون في الدين ما ليس من الدين، وذلك مثل الذي يحدث في المساجد وغيرها من العبادة من البدع، حتى أن بعض يترك السنة فلا يلومه أحد، ويأتي بالبدعة فيعاتبه بعض الناس ويتبعه كثير من الناس على بدعته، وكون الإنسان يلتبس عنده الحق بالباطل حتى يتعبد لله بما لم يشرعه الله يكون بذلك قد وقع في خطر عظيم. الضرر الرابع: أن صاحب البدعة محروم من ثواب العمل الذي يعمله، وقد سبق أن ذكرت حديث عائشة: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). الضرر الخامس: صاحب البدعة يحرم من الورود على حوض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم القيامة، ويدعو عليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وفي ذلك يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ألا ليزدن رجال عن حوضي، كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا؛ فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا)). الضرر السادس: صاحب البدعة ملعون؛ لقول -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحدث فيها أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين)). الضرر السابع: صاحب البدعة عليه إثم من قلده وعمل بالبدعة التي يعمل بها؛ لقوله تعالى: {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [النحل: 25]. وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)). الضرر الثامن: التعبد بالبدع يؤدي إلى سوء الخاتمة، والعياذ بالله -تبارك وتعالى- أكثر الناس شكًّا واضطرابًا عند الموت هم أصحاب البدع؛ وذلك لسوء الاعتقاد وفساد القلوب ولمرضها بالشبهات والشكوك، وقد يظهر لهم من معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقداتهم، وسوء منقلبهم؛ فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط. وأهل السنة -رحمهم الله تبارك وتعالى- هم أكثر الناس ثباتًا على أقوالهم ومعتقداتهم؛ لأن الثبات على الحق هو شيم أهل الحق. وقد قال هرقل لأبي سفيان بن حرب سائلًا إياه عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "هل يرتد أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: لا، قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب". وقال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتمة، قال: الفساد في الاعتقاد، والتعبد بالبدع، وإن كان مع كمال الزهد والصلاح، فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعًا به متيقنًا له غيرَ ظانٍّ أنه أخطأ فيه فإنه قد يكتشف له حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من المعتقدات الحقة مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له، إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. وهنا قد يقع في الضلال عندما يعتقد بطلان الحق الذي هو عليه قبل أن يموت؛ وبالتالي يخرج من الدين بالكلية، ويختم له بالسوء، ويخرج من الدنيا بغير إيمان -والعياذ بالله تبارك وتعالى- وقد ختم لكثير من البشر بالسوء، بسبب ما ابتدعوا في دين الله -عز وجل- وزاغوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم، وظهرت حقيقتهم في أول لقاء لهم مع رب العالمين. الضرر التاسع: أن المبتدعة لا تقبل له توبة، وليست له توبة إلا إذا صدق مع الله -عز وجل- ورجع إلى الله وسَلَّمَ أما أن سار في غيه؛ فلا يقبل الله -سبحانه وتعالى- منه عملًا. قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة))، والحجر هو المنع. وفي رواية البيهقي: "احتجب"، يعني: إن الله -عز وجل- حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وإن كان زاهدًا متعبدًا فعاقبته خطيرة جدًّا؛ لأن البدع تجعل عمل صاحبها مردود عليه لا يقبل بحال من الأحوال. إن العقيدة الصحيحة هي الأصل في قبول الأعمال؛ بشرط عقد النية الصادقة لله وحده، وموافقتها للكتاب والسنة؛ وذلك لأن العمل لا يوصف بالصلاح إلا في ضوء عقيدة الإيمان الخالص لله وحده لا شريك له؛ فإذا كان العمل في ظل عقيدة فاسدة، أو نقضت هذه العقيدة إن كانت صالحة بما دخل عليها من أمور أو معتقدات فاسدة؛ فعندئذ تحبط جميع الأعمال، وتذهب هباءً منثورًا، ولا يجد الإنسان لها أثرًا في حياته ولا بعد موته؛ قال تعالى: {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ چ} [الفرقان: 23]. ولذلك أقول: إن سلامة المعتقد -أو صحة المعتقد- أساس وأصل لقبول العمل؛ فالله -عز وجل- لا يقبل عملًا قام به إنسان ما وهو صاحب عقيدة فاسدة. ومن هنا كانت التشديد والبيان على أهمية العقيدة الصحيحة وما هي العقيدة الصحيحة؛ لأن أصحاب البدع استحسنوا أمورًا وأدخلوها في دين الله من غير دليل من كتاب أو سنة؛ فضل بذلك سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. والبدع التي أدخلها كثير من الناس -سواء كانت في الاعتقادات الشائعة أم في العبادات- محبطة للأعمال؛ لأن مثل هذا كمن يكتب على الماء أو يبني على الرمال من غير أساس، والأساس في الأعمال هو الإيمان الخالص بالله -عز وجل- الذي لا يشوبه أيُّ لونٍ من ألوان الشرك أو البدع في مسائل الاعتقاد، ولنتأمل قول رب العالمين سبحانه: {ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ} [الكهف: 110]. والمذهب الصحيح في العقيدة هو ما ذهب إليه السلف الصالح وتمسكوا به، وهو عقيدتنا -بحمد الله تبارك وتعالى وفضله- ونحن نحمد الله -عز وجل- على نعمة التوحيد الخالص وعلى سلوكنا منهج أهل السنة والجماعة، وتقرير مذهب السلف في ذلك: هو إيماننا الصادق والخالص بوحدانية الله -تبارك وتعالى- في ملكه، وقد عز ربنا -سبحانه وتعالى- وكمل سلطانه: {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ} [الشورى: 11]، {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [الإخلاص: 4]. ونسمي ربنا -سبحانه وتعالى- بما سمّى به نفسه، وننسب إليه ما نسب لنفسه، ونصفه بما وصف به نفسه دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل، وهذا هو معتقد السلف الصالح في ذلك، وأنه -سبحانه وتعالى- فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب غيره، وأنه -جل وعلا- موصوف بكل الكمال، منزَّهٌ عن كل نقصان، جل جلال ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدًا. ومن ثم؛ فكل ما ورد في كتاب الله نؤمن بما أثبت الله لنفسه فيه، وأثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- من كل عيب أو نقص إجمالًا وتفصيلًا، ونؤمن به كما ورد؛ لا دخل للعقل في مراده؛ لأننا لا نعرف كيفية رب العالمين سبحانه، ولا يوجد للعقل مجال في مثل ذلك؛ بل يجب علينا أن نقف عند حدود النصوص الواردة، وإن نقف أيضًا عن التأويل والتمثيل والتعطيل، فلا نؤول الصفة بأن نصرفها عن ظاهرها، أو أن نمثل الله بخلقه ونشبهه -سبحانه وتعالى- بأحد من مخلوقاته لأنه -جل وعلا-: {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ}. ومن النصوص التي وردت في صفات الله -عز وجل- وأثبتها ربنا لنفسه: ما جاء في قول الحق سبحانه: {پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [الأعراف: 54]، وكقوله: {ڈ ژ ژ ڑ} [طه: 5]، وكقوله: {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [الملك: 16]، وقال عن نفسه سبحانه ممجدًا إياها: {ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ} [فصلت: 54]، {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے} [الزخرف: 84]، وقال سبحانه: {ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [ق: 16]، وقال عن إبراهيم -عليه السلام-: {ﮥ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮰ ﮱ} [الأنعام: 79]، وقال سبحانه عن قوم فرطوا عن عبوديتهم لله، وأنهم يوم القيامة سيندمون ويتحسرون، ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، وقال سبحانه واصفًا نفسه بأن له عين: {ﭬ ﭭ ﭮ} [طه: 39]، وبأن له يد: {پ پ پ ﭚ} [الفتح: 10]. وهناك الكثير والكثير من الآيات القرآنية وكذلك من الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات لصفات رب العزة والجلال سبحانه، ومن ذلك مثلًا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن))، وكقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل)). ونحن أمام هذه الصفات كلها -كإثبات صفة الضحك لله مثلًا، أو الغضب، أو الرحمة... وغير ذلك- نكِلُ العلم في حقيقتها وكيفيتها إلى الله، ولا نعلم منها إلا ما فهمه السلف وصحابة النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- على مقتضى قواعد لغة العرب وما خوطبوا بها؛ فنحن نفهم الصفة وما تدل عليه دون أن نكيفها أو أن نسعى في معرفة حقيقتها؛ لأنه لا يعرف رب العالمين سبحانه إلا هو -جل في علاه. ومن هنا كان من منهج السلف الواضح هو الإقرار الكامل، وكذلك أيضًا من منهج الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- الإقرار بصفات الله تعالى، وعدم تأويلها أو ردها أو إخراجها من ظاهرها، ولم يثبت بحال أن صحابيًّا واحدًا تأول صفة من صفات الله -تبارك وتعالى- أو ردها، أو قال فيها: إن ظاهرها غير مراد؛ بل كانوا يؤمنون بمدلول الصفات ويحملونها على ظاهرها، وهم يعلمون بلا شك أن صفات الله -تبارك وتعالى- ليست كصفات المحدثين من خلقه؛ لأنه -سبحانه وتعالى- لا سميَّ له، ولا ند له، ولا كفء له -جل في علاه. قد سئل الإمام مالك -رحمه الله، تبارك وتعالى- عن قول الله -عز وجل-: {ڈ ژ ژ ڑ} [طه: 5]؛ فقال -رحمه الله-: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل: ما أراه إلا مبتدعًا. وأمر بإخراجه. وكان الإمام الشافعي -رحمه الله تبارك وتعالى- يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وبما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على مراد رسول الله -عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام أحمد -رحمه الله، تبارك وتعالى- يقول في مثل قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله ينزل إلى السماء الدنيا)) وأن الله -عز وجل- يُرَى يوم القيامة، وأنه تعالى يعجب ويضحك ويغضب ويكره ويرضى ويحب، كان يقول في هذه الصفات: نؤمن بها ونصدق بها، لا بكيف ولا بمعنى. يعني: لا بمعنى على الحقيقة وإن كان معانيها في اللغة وما يدل عليها ظاهرها المراد مفهوم من لغة العرب، يعني: إننا نؤمن بالله تعالى ينزل ويُرى، وهو فوق عرشه بائن من خلقه؛ ولكننا لا نعلم كيفية النزول ولا الرؤية ولا الاستواء، ولا المعنى الحقيقي لذلك؛ بل نفوض الأمر في علم ذلك إلى الله -سبحانه وتعالى- الذي قاله وأوحى به إلى نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا نرد على رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- مع اعتقادنا يقينًا أن الله {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ٹ}. قال الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله، تبارك وتعالى- في قول الله -عز وجل-: {پ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} قال: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مَن أوّل فقد عبد عدمًا، ومَن شبَّه فقد عبد صنمًا، وقال الشيخ عبد اللطيف المشتهري -رحمه الله-: إذا كنا نؤمن بالجن والملائكة ولا نعرف عن حقيقتهم شيئًا، ونؤمن بالروح ولا نعرف شيئًا عن بدايتها ونهايتها، ولا كيف نزلت إلى الجنين ولا كيف صعدت عند الموت، وإذا كنا لا نعرف حقيقة الكهرباء، ولا سر النوم، ولا ندرك من عظمة الكون إلا كما تدرك النملة من سطح الجبل شاهق مديد؛ بل لم ندرك من خطايا نفوسنا وأعضائنا وطبائعنا ومشاعرنا وإبداع خلقنا بدنًا ونفسًا وعقلًا وروحًا، إذا كنا كذلك -يعني لا نعرف هذه الأمور وهي قريبة منا؛ بل بعضها في داخلنا كالنفس والعقل- فكيف إذًا نحيط برب هو مالك الأملاك -سبحانه وتعالى- برب الملك والملكوت، وما نحن إلا من صنعه سبحانه -جل وعلا. وبالتالي وجب علينا أن نثبت الكمال المطلق لله -عز وجل- والجلال، والعلو، والأسماء الحسنى؛ إما ذاته سبحانه فهي محجوبة عنا لا نعلمها، ولا نعلم حقيقتها، ولا نعرف كيفيتها؛ لأننا لا نعرف كيف رب العالمين سبحانه، ولا كيف ذاته، وبالتالي نقول: لا ندري حقيقة الاستواء، ولا كيفية الغضب، ولا الرضا... ولا غير ذلك من سائر الصفات التي أثبتها ربنا لنفسه، ووجب علينا أن نؤمن بها إيمانًا حقيقيًّا لله تاركين الكيف فيها لله -عز وجل. ولقد خاضت فرق في هذه المسائل سيأتي الإشارة إلى بعضها -إن شاء الله، تبارك وتعالى- وهي من البدع في مجال العقائد. أ- التعريف بهم: كان خروج الخوارج في عهد علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- في سنة ستٍّ وثلاثين من الهجرة النبوية؛ وسمو بالحرورية؛ لأنهم نزلوا حروراء؛ وسمو بالخوارج لكونهم خرجوا عن الطواعية –يعني: عن طواعية الإمام- وابتدعوا، وكانت بدعتهم أنهم يكفرون بالذنوب؛ فيجعلون الذنب -ولو كان صغيرًا- مخرجًا من الملة، ويحملون بعض الآيات التي نزلت في الكفار على المؤمنين أو على بعض العصاة الموحدين. وقد أنكر السلف -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- هذه البدعة وقاتلوهم عليها لما بدءوا بالقتال وبقوا على هذه البدعة الشنيعة، ولم يزل من هم على عقيدتهم إلى يومنا كالطائفة المسماة بالأباضية، وكذلك فرق التكفير التي ظهرت لها نوابت في سائر بلاد العالم الإسلامي. وبدعة هؤلاء في الحقيقة تتعلق بالعقيدة، ونحن نتحدث عن البدع في مجال العقائد؛ تتعلق بالعقيدة لأنهم يكفِّرون المسلمين بالذنوب ويخلدون العاصي في النار، ويخرجون المسلم بالمعصية من الإسلام، ويستحلون دم المسلم الذي أذنب، ويقاتلون المسلمين، وهذا ذنب كبير وبدعة شنيعة. أنكر عليهم في ذلك أئمة السلف -رحمهم الله، تبارك وتعالى- وهؤلاء أنكروا عفو الله -عز وجل- بقولهم هذا، وأنكروا تجاوز رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن الذنوب، كما أنكروا أحاديث الشفاعة التي فيها: أن الله تعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويقبل التائب ويعفو عن المسيء، وأنكروا شفاعة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأنكروا شفاعة الملائكة الكرام في أهل التوحيد، وبهذا يكونون وقعوا في أمر عظيم فارقوا فيه العقيدة الصحيحة. ومع كل ذلك؛ فقد وصف هؤلاء الناس في الأحاديث بكثرة الأعمال، وأنا أؤكد على هذا وأركز عليه، حتى لا يغتر أحد بهؤلاء المكفرين الذين يخرجون المسلمون بالذنوب والمعاصي والسيئات، وصفوا في الأحاديث بكثرة الأعمال؛ يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يخرج في هذه الأئمة قوم تحقرون صلاتهم مع صلاتكم، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو قال: حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية)) وفي رواية: ((لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد))، وقد قاتلهم علي -رضي الله تعالى عنه- وبقي منهم بقايا قاتلهم المسلمون في عهد بني أمية، وكادوا أن يقضوا عليهم ولكن كان منهم أفرادٌ لم يزالوا يدعون إلى ملتهم وعقيدتهم إلى يومنا هذا. ب- ذكر أهم مبادئهم: المبدأ الأول: صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في أول ولايته، وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وعمر وقدم أقاربه. المبدأ الثاني: صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم؛ ولما أخطأ في التحكيم كفروه مع الحكمين وطعنوا في أصحاب الجمل. المبدأ الثالث: الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين، وسواء كان المختار قرشيًّا أو عبدًا حبشيًّا، وليس من حق الإمام أن يتنازل أو يحكم لأحد؛ وإنما عليه أن يأخذ بما يجب عليه نصًّا ظاهرًا واضحًا -هكذا قالوا- من الكتاب ومن السنة، وقالوا: يجب عليه أن يخضع خضوعًا تامًّا لأوامر الدين وإلا وجب عزله. المبدأ الرابع: العمل بأوامر الدين، وأن هذه الأوامر جزء لا يتجزأ من الإيمان، وكل من عصى الله يكون كافرًا، والذنوب جميعها كبائر. المبدأ الخامس: وجوب الخروج على الإمام الجائر، ولا يقولون بالتقية، كما تذهب إلى ذلك الشيعة. جـ- شرح أهم أصولهم البدعية: الأصل الأول: زعمهم أن الإيمان شيءٌ واحد لا يتركب ولا يتجزأ: فالإيمان عندهم حقيقة واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ؛ فمتى ذهب بعضه ذهب كله، فلم يبقَ منه شيء، وتفرع عن هذا الأصل البدعي بدع أخرى؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية... وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، والصواب: أن الإيمان له أصل شعب متعددة، تبدأ من الشهادتين، وتنتهي بإماطة الأذى عن الطريق، ومن هذه الشعب ما يزول الإيمان بزواله إجماعًا كقول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين لفظًا، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعًا كترك الأذى عن الطريق. الأصل الثاني: تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار: وهذا الأصل متفرع عن الأصل السابق؛ حيث قالت الخوارج: الطاعات كلها من الإيمان؛ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، وبالتالي يذهب جميعه؛ لأنه شيء من الإيمان، ومن ثم حكموا بكفره وخلوده في النار. قال الإمام النووي -رحمه الله-: واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة، وما عليه أهل الحق من السلف والخلف: أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال؛ فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير والمجنون والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لن يبتلى بمعصية أصلًا؛ فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلًا، وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة؛ فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة؛ وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده -سبحانه وتعالى- ثم يدخله الجنة؛ فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. الأصل الثالث: تكفيرهم لعثمان وعلي -رضي الله عنهما-: إن من أشنع أصول الخوارج البدعية تكفيرهم لبعض الصحابة؛ حيث إنهم يكفرون عليًّا وعثمان، ويكفرون الحكمين، ويكفرون أصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين، قال ابن تيمية -رحمه الله-: والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم أنهم يتوهمون في بعض الأخيار أنهم من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلي -رضي الله عنهما- وأتباعهما أنهما مخلدون في النار، ويبنون مذاهبهم على باطلين: أحدهما: أن فلانًا من أهل الكبائر، الثاني: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. وصفوة القول في أصحاب نبينا عامة وفي العشرة المبشرين والأربعة الخلفاء المهديين خاصة: هو ما قرره صاحب (العقيدة الطحاوية) بقوله: "ونحب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا نفرق في حب أحدٍ منهم، ولا نتبرأ من أحدًا منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان". الأصل الرابع: وجوب الخروج على الظَّلَمَةِ من الأئمة: قالت الخوارج بوجوب الخروج على الأئمة الظلمة؛ بل قالوا بوجوب قتالهم، وكانوا هم أصحاب غارات وثورات، وتوسعوا في سفك دماء المسلمين وفرقوا كلمتهم، وشقُّوا عصى الطاعة بناءً على هذا المبدأ الفاسد، قال الأشعري عنهم: ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور، ومنعم أن يكونوا أئمة بأي شيءٍ قدروا عليه بالسيف أو غير السيف. قال صاحب (الطحاوية) -رحمه الله- مبينًا عقيدة أهل السنة في ذلك: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وجل- فريضة، ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وفي الحديث: ((مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه مَن فارق الجماعة شبرًا فمات، إلا مات ميتة الجاهلية))، وفي الصحيحين: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). الأصل الخامس: إنكارهم لحجية السنة: لقد خالفت الخوارج ما عليه المسلمون من التمسك والاحتجاج التام بسنة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ففي الوقت الذي أظهروا فيه التمسك الشديد بظاهر القرآن؛ أغفلوا التمسك بالحديث النبوي حتى المتواتر منه، وردوا ما خالف ظاهر القرآن عندهم. قال ابن تيمية -رحمه الله-: الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف الظاهر، أو دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم؛ فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابًا، وقال أيضًا: وإذا عرف أصل البدع؛ فأصل قول الخوارج: أنه يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر القرآن وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه -لارتداده عندهم- ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. الأصل السادس: موقفهم من الصفات الإلهية: يتفق موقف الخوارج في الصفات مع موقف المعتزلة إلى حدٍّ بعيد؛ فهم في الجملة من النفاة المعطلة، ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، والقرآن لديهم مخلوق، يقول الأشعري -رحمه الله تعالى- عنهم: الخوارج يقولون جميعًا بخلق القرآن. أ- التعريف بالشيعة: الشيعة هم أصحاب الرأي القائل بأولوية آل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالخلافة، وأحق آل البيت هو علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- وقد ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان -رضي الله عنه- ونمى وترعرع في عهد علي -رضي الله عنه- ولِما لعليٍّ من المكانة الممتازة في الإسلام أخذوا ينشرون نحلتهم بين الناس؛ ولما جاء العصر الأموي، ووقعت بعض المظالم على العلويين آل البيت، ورأى الناس في علي وأولاده أنهم لقوا بعض الظلم؛ انتشر المذهب الشيعي بسبب ذلك وكثرت أنصاره. والشيعة منهم المغالي والمقتصد؛ فالمعتدلون اقتصروا على تفضيل عليٍّ على بقية الصحابة من غير تكفير لأحد، ولم يرفعوه إلى مرتبة النبوة؛ أما المغالون فلم يكتفوا بتفضيله على الخلفاء وعصمته؛ بل رفعوه إلى مرتبة النبوة، ومنهم من ألهه، ومنهم من زعم حلول الإله فيه، ومنهم من قال: كل روح إمام حلت فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام الذي يليه. وقد كان التشيع بهذه الأفكار المنحرفة، والتي سأذكر بعضها فيما يأتي بعدُ -إن شاء الله، تبارك وتعالى- كان مباءةً خصبة لظهور الرجعة والحلول، والتناسخ والتجسيد، وعدم ختم النبوة. والحق الذي لا مرية فيه أن التشيع كان ملجأً لجأ إليه كل من يريد هدم الإسلام لعداوةٍ أو حقدٍ، ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية ومجوسية... وغيرهم، كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارًا يضعون وراءه كل ما شاءت أهوائهم. ب- ذكر أهم مبادئهم: المبدأ الأول: ذكروا فيه: بأن الإمامة فيه ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأئمة؛ بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفالها؛ بل يجب عليه تعيين لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وسأوضح ذلك بعد قليل -إن شاء الله. المبدأ الثاني: قالوا فيه: بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عين عليًّا بنصوص لا تحتمل التأويل، وكانوا ينقلون هذه النصوص، ومن هنا نشأت فكرة الوصية عندهم، ولقب علي بالوصي؛ فهو إمام بالنص لا بالانتخاب، وقد أوصى علي لمن بعده، وهكذا كل إمام كان إمام يوصي لمن يأتي بعده. المبدأ الثالث: قالوا فيه: إن عليًّا هو أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فمن عاداه أو حاربه؛ فهو عدو الله إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه. المبدأ الرابع: التقية، ومعناها عندهم: أن يحافظ على عرضه ونفسه وماله، مخافة عدوه؛ فيظهر ما لا يبطن؛ فهي مدارة وكتمان؛ بل قالوا: لا دين لمن لا تقية له، ويعنون بالتقية هنا -وهي إضمار ما لا يظهرون-: إضمار ما لا يظهرونه لأهل السنة؛ فيتعاملون مع أهل السنة من منطلق التقية؛ فيظهرون لهم ما يبغضونه تجاههم. المبدأ الخامس: الإمام عندهم يعلم الظاهر والباطن؛ ولذلك خرجت منهم فكرة المهدي المنتظر، الذي يأتي فيملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا، ومهدي الرافضة ليس هو المهدي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وهو الذي يكون في آخر الزمان؛ فمهدي الرافضة يزعمون أنه إمام غائب. ج- شرح أهم أصولهم البدعية: هؤلاء الشيعة الرافضة لهم أصول بدعية كثيرة، سأبدأ بذكر شيءٍ -وتفصيل القول فيه- من مبادئهم البدعية عقيدتهم في الإمامة، وهم يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. ولعله من المناسب أن أذكر أولًا مذهب أهل السنة والجماعة في الإمامة، ثم أبين مدى مخالفة هؤلاء في معتقدهم لعقيدة المسلمين: أهل السنة والجماعة يرون إن الإمامة قضية مصلحيه تناط لاختيار الأمة من أهل الحل والعقد، وينتصب الإمام بنصبهم، كما أنها تصح بعهد من الإمام الميت إذا أراد أن يختار للأمة رجلًا حسنًا عند موته ولم يقصد بذلك هوًى؛ ولهذا فأهل السنة يرون وجوب نصب إمام يقيم شعائر الدين، وينتصف، وينصف المظلومين من الظالمين. يقول الماوردي -رحمه الله-: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. ويقول أبو المعالي الجويني -رحمه الله-: اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة. هذا موقف المسلمين عمومًا من قضية الإمامة؛ وإنها واجبة ليسوس الإمام الراعية، وكي يقيم العدل ويدفع الظلم... إلى غير ذلك من متطلبات الإمامة والتي لا يمكن تحققها إلا بوجود إمام؛ إما أمر الإمامة عند الشيعة الرافضة "الإثنا عشرية" فله شأن آخر ومعتقدٌ جديد يخالف عقائد المسلمين؛ فهي عندهم أصل من أصول الدين وركن من أركانه، ولا يتم إيمان المرء إلا بهذا الاعتقاد: يقول الشيعي الرافض محمد رضا المظفر: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا باعتقادها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا؛ بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. وقال الرافضي ابن المطهر الحلي في مقدمة كتابه (منهاج الكرامة): أما بعد؛ فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين: وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، "وهي أحد أركان الإيمان". تأمل العبارة عن الإمامة قال: "وهي أحد أركان الإيمان". وهذا في الحقيقة غلو شديد في مسألة الإمامة. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين زعموا أن الإمامة أجلُّ من النبوة، وقد ذكر ذلك هادي الطهراني أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر؛ حيث قال: الإمامة أجلُّ من النبوة؛ فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخُلة. وقد بنى الروافض الإمامة معتقدهم هذا على روايات مكذوبة نسبوها كذبًا وزورًا إلى آل البيت -رضي الله عنهم- وأنا أنص على ذلك وأبينه حتى لا يغتر أحد بما ينقلونه ويرددونه، ومن رواياتهم المكذوبة في ذلك ما جاء في كتاب (الكافي)، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، وهو الكليني، روى بإسناده عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادِ بشيءٍ كما نودي بالولاية. ولعلنا نلحظ في هذا النص السابق أنه قد أسقط منه الشهادتين، والشهادتان من أركان الإسلام، ووضعوا مكانهما "الولاية"، والشهادتان أعظم أركان الإسلام، وبهما بدأ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حديثه عن أركان الإسلام؛ وبهذا نعرف مناقضة الشيعة الرافضة لأصل دين الإسلام؛ بل أنهم لم يقتصروا على ذلك عندما جعلوا الولاية أفضل أركان الإسلام؛ بل أفضل من أركان الإسلام الأخرى. فقد روى أيضًا الكليني بسنده عن أبي جعفر أنه قال: إن الإسلام بني على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيءٍ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ قال: الصلاة. ولذلك أقول بأن هذه من المعتقدات البدعية لدى هؤلاء، وقد رد عليهم أئمة أهل العلم في هذه المعتقدات الباطلة، ومن ذلك شيخ الإسلام الذي هو الإمام العالم العلامة الرباني، الإمام ابن تيمية -رحمه الله- فند قولهم في مسألة الإمامة وغيرها، ولكنه قال كلامًا سديدًا موفقًا في مسألة الإمامة، قال فيه: إن قول القائل: إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذبٌ بإجماع المسلمين؛ فإن الإيمان بالله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمنًا حتى يشهد إن لا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- الكفار أولًا، كما استفاض عنه في (الصحاح) وغيرها: أنه قال: ((أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)). د- عصمة الأئمة عند الشيعة: وهي مسألة مهمة جدًّا تابعة لمعتقدهم في الإمامة: عصمة الأئمة من أهم الأمور الدينية عند الشيعة، ولها صلة وثيقة بعقيدتهم، وقد اتفقوا على عصمتهم، وأنه لا تقع المعصية منهم لأنهم جميعًا حجج الله؛ ولذلك فهم معصومون من الزلل، بل إن الأئمة عند الشيعة الرافضة ليسوا معصومين من الكبائر والصغار فقط؛ بل من كل شيء حتى السهو والنسيان. يقول ابن أبي الحديد: لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر لا عمدًا ولا خطأً ولا سهوًا، ولا على سبيل التأويل والشبهة، وذكر أن مثلهم في ذلك كمثل الأنبياء، ويقول محمد رضا المظفر: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سنة الطفولة إلى الموت عمدًا وسهوًا. وقد أجمع السابقون منهم واللاحقون على هذه العقيدة الباطلة، يقول الخميني: نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة -رضي الله عنهم- وهذا المنصب لا يتصور فيه السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين. وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن ابن سبأ -هذا اليهودي الذي أعلن إسلامه لإفساد هذا الدين، وهو الذي روج هذه العقائد الباطلة عند الشيعة- كان وراء القول بعصمة الأئمة، وفي ذلك يقول ابن تيمية: وكذلك أول ما ابتدعت مقالة الغالية في الإسلام من جهة من كان قد دخل في الإسلام وانتحل التشيع، وقيل: أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًّا فأسلم، وابتدع القول بأن علي إمام منصوص على أئمته، وابتدع أيضًا القول بأنه معصوم، يعني هذا الرجل -ألا وهو عبد الله بن سبأ- ابتدع هذه البدعة، وهو الذي ذكر بأن الإمام عليًّا هو منصوص عليه، وأن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- نص على إمامته، وأنه أيضًا معصوم، وإن العصمة الثابتة له كعصمة غيره من الأنبياء، وهذا لا شك باطل. هـ- عقيدة هؤلاء الشيعة الرافضة في القرآن الكريم: إجماع المسلمين على أن كتاب الله -عز وجل- محفوظ بحفظ الله له؛ قال تعالى: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحجر: 9]، وقال رب العالمين عن كتابه: {گ گ گ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [فصلت: 42]، ومن اعتقد -بعد هذا- أن في القرآن نقصًا أو تحريفًا فليس من الإسلام في شيء؛ لتكذيبه لنصوص القرآن الكريم. وقد قال بعض الشيعة بهذا القول وأقروه، وقد نسب الأشعري ذلك لطائفة منهم، وذكر أنهم قالوا: إن القرآن قد نقص منه، وأما الزيادة فذلك غير جائز إن يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أن يكون غُيِّر منه شيء على عما كان عليه. كما أشار البغدادي -رحمه الله- إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه، واعتبر البغدادي ذلك من موجبات الحكم بكفرهم وخروجهم عن الإسلام. وأنا أقف عند كلمة البغدادي التي يقول فيها: إن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. هذا طعن على صحابة النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا أيضًا من المعتقدات الفاسدة عند هؤلاء القوم؛ ولذلك البغدادي -رحمه الله- يعتبر أن هذا المعتقد -وهو القول بتحريف القرآن والطعن على صحابة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يوجب الحكم بكفر هؤلاء. أما ابن حزم -رحمه الله، تبارك وتعالى- فقد نسب القول بالتحريف إلى الإمامية كلها، ولم يستثنِ من إعلام الإمامية إلا ثلاثة نجو من الوقوع في هذه الهاوية. ولا بد هنا أن أوثق كلامهم، لعل الذي يدرس هذه الدروس يتعجب: كيف أن قوم ينتسبون للإسلام يقولون بأن القرآن الكريم محرف! سأنقل من كلامهم الذين ذهبوا فيه إلى أن القرآن الكريم وقع فيه بعض التحريف. يقول أحد مشايخهم المدعو محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمدٍ -صلى الله عليه وآله وسلم- باختلاف القرآن، وما أحدث بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. ويجب أن أشير أيضًا هنا إلى أنه يريد بقوله: "وما أحدث بعض الطاعنين فيه": صحابة النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم. كما أورد الكليني في كتابه (الكافي) روايات في تحريف القرآن وهو من الكتب المعتبرة عندهم؛ ولذلك قال الفيض الكاشاني عنه: إنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن الكريم. وفي القرن الثالث عشر الهجري ألَّف شيخهم -حسين النوري الطبرسي، وهو يحظى بالتعظيم عندهم- مؤلفًا كبيرًا جمع فيه أقوال المتقدمين منهم في تحريف القرآن الكريم وسماه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب). وقد كشف الطبرسي بهذا الكتاب حقيقة موقف الرافضة ومراجعهم في القرآن الكريم، وأبان عما يحملونه من كيد حاقد وعداوة مبيتة ضد كتاب الله -عز وجل- وقد أشار في مقدمة كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب: قال في مقدمته: فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي -جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه-: هذا كتاب لطيف، وسفرٌ شريف، عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته: (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب). ولا شك أن الخميني يذهب إلى ما ذهب إليه من الروافض في القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم وهو، وإن لم أقف تصريح له من باب التقية في هذه القضية؛ إلا أنه يستقي حديثه من كتاب (مستدرك الوسائل)، ويترحم على صاحبه، وهو صاحب (فصل الخطاب) السابق ذكره؛ كما أنه يستقي معلوماته من (تفسير الصافي) وهو من القائلين بوقوع التحريف في القرآن الكريم. وقبل أن أنتهيَ من هذا المقام الشنيع سأذكر نماذج ذكرها هؤلاء القوم وزعموا فيها أنها نصوص محرفة، وناقصة من كتاب الله -تبارك وتعالى- وسأذكر ذلك أيضًا من كتبهم: مثلًا يقول القُمِّي: وأما ما هو محرف؛ فمنه قوله تعالى: {ک ک ک گ گ گ} [النساء: 166] "في علي". يعني يقول: بأن هذه الآية سقط منها هذا القول. وأيضًا يقول في قول الله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [النساء: 166] أيضًا "في علي"، ومثلها: {چ چ چ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [المائدة: 67] يعني: "في علي". ويعني أن الصحابة هم الذين حذفوا ذلك. وقد عقب الدكتور ناصر القفاري على هذه الافتراءات على القرآن الكريم فقال: وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة أنها ناقصة من كتاب الله؛ إلا يلاحظ القارئ العربي أن السياق لا يتقبلها، وأنها مقحمة إقحامًا بلا أدنى مناسبة؛ ولذلك يكاد النص يلفظها، وأنها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب، ولا معرفة بأساليب العربية، ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وأدراك المعاني. هذه بعض المعتقدات الفاسدة عند هؤلاء الرافضة، ويطول المقام بنا كي نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل في جميع عقائدهم؛ فعندهم أيضًا عقيدة الرجعة والغيبة، وعقيدة أنهم يستحلون نكاح المتعة وغير ذلك من الأمور الفاسدة. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 على هذه المحاضرة الماتعة وكذلك على تفريغ الدرس ولكن ارجو ضبط الآيات بخط عادى لتظهر صحيحة. كذلك انصح بتجزئة الدرس على عدة مشاركات ليسهل مطالعته. على هذه المحاضرة الماتعة وكذلك على تفريغ الدرس ولكن ارجو ضبط الآيات بخط عادى لتظهر صحيحة. كذلك انصح بتجزئة الدرس على عدة مشاركات ليسهل مطالعته.كذلك ارجو استكمال نفس الموضوع على نفس الرابط هنا. 
__________________
 قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
في كل عصر هناك بدع , وما ابداعات داعش الان التي تشرت مؤخرا الا واحدة من تلك البدع
|
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
link
تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية





