 |
| جديد المواضيع |

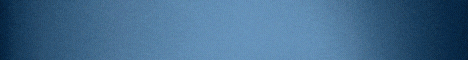
| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
| منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
اللغةُ العربيّةُ لِسانُ الحَضارةِ الإسلاميّة الدكتور عبد الرحمن بودرع يُعدّ اللّسان في كل أمةٍ جلاءَ الأذهان وصقلَ الخواطر وديوانَ الأخبار والآثار. وإن لسان العرب المبين، من أبين الألسنة دلالةً، وأوسعِها معجمًا، وأذهبِها في فنونِ القولِ والبلاغةِ، وصنوفِ البيان والفصاحةِ، ممّا خدم الكتابَ المنزلَ، وكلامَ نبيّه المُرْسَل، وكان عوْنًا على فهمِهما. ولقد عُني به العلماء منذ القديم وخصُّوه بعنايةٍ لم يَحْظَ بها أي لسانٍ آخر؛ فوضعوا له الضوابطَ، خَشيةَ تفشّي اللّحن فيه، وجَمَعوا مُفرداتِه وعباراتِه من البوادي ومَظانِّ الفَصاحة، جمعوا الشعر من رُواته، والأمثالَ والخُطبَ من القبائلِ، وأسّسوا علومَ النحو والصّرف والبلاغة والعروض. لقد أنفقوا الأعمارَ في خدمةِ اللّغة، وبذلوا أنفسَهم لحمايةِ حواشيها من أعاصيرِ الزّمن. فظلّت لغةُ العربِ إلى قِدَمِها، متجددةً متطوِّرةً، متّصلةً اتِّصالاً عضويًا بالطبيعة والحياة، وشؤون العبادةِ، وبُنِيَتْ على أسُسِها حضارةٌ شامخةٌ، ظلّت لَها الغَلَبَةُ والظّهورُ طيلةَ قُرونٍ. ولكن مرّت بهذا اللّسان قرونٌ تالِيَةٌ، تقلَّبَ فيها بين الصّعودِ والهبوطِ، والغزارةِ والنّزارة، وأتى عليه حينٌ من الدّهرِ عصفت به رياحُ التّغيير، وتبيَّن للعاقل - في زماننا هذا - تغيُّرُه، ولاح للّبيب تبدّلُه؛ حيث كاد يذبل فرعه بعد النضارة، واعترتْه بين أهلِه وذويه حالَةٌ شديدةٌ من الغُرْبَة، وهمومٌ وكُرْبة، وتَهديدٌ بالانقراضِ. ولا غَرْوَ، فإنّ هذ اللّسانَ المبينَ، اعتراه من الفتن ما اعترى هذا الدّين، من النّوى والغربة، في وطنِه وعُقرِ دارِه. * * * وبعدُ، فإنّ اللّغةَ نعمةٌ من النّعمِ التي لا ينفكُّ الإنسانُ ينتفعُ بها، وهبةٌ عُظْمى لا تقلُّ عن نعمةِ الحواسِّ التي يُدْرِكُ بها العالَم. وإنّ اللّسانَ يتحرّكُ بحُروفٍ معدوداتٍ، ثمّ يُزاوجُ بينها فتصيرُ مَقاطِعَ، وبينَ المقاطعِ فتصيرُ كلماتٍ، يدلُّ بها على كلِّ ما تقعُ عليه حواسُّه وما ينبضُ به قلبُه وما تجيشُ به عواطفُه، ثمّ يزاوجُ بين الكلماتِ فيؤلِّفُ منها المقالاتِ والفصولَ والمُصَنَّفاتِ، فتتحوّلُ هذه إلى علومٍ وفنونٍ وآدابٍ، وفَلْسَفاتٍ وأفكارٍ ومَناهجَ، ومدنيّاتٍ وحَضاراتٍ، وإذا بها عوالمُ تضجُّ بالحياةِ والحركةِ، وتموجُ بشتّى الأحاسيسِ والأفكارِ، والأشكالِ والألوان. وهي قبلَ ذلكَ كلِّه يستعملُها النّاسُ للتّفاهُمِ والتّلاقُحِ والتّواصلِ، ولولم تكن للنّاسِ لغةٌ يتخاطبون بها لما عرفوا لهم هدفًا، ولما استطاعوا وصْلَ ماضيهم بحاضرِهم، ولا نقلَ المعرفةِ من جيلٍ إلى جيلٍ. ولكنّ الإنسانَ من فَرْطِ إلْفِه بها واعْتِيادِه عليها لا يُبْصِرُ سرَّ قوّتِها ووجهَ الجدَّةِ فيها، فقد تسلَّمَها من أسلافِه وفرَّطَ في حقِّها، فلم يوفِّها ما تستحقُّ من العنايةِ والرّعايةِ، حَتّى باتت مهدّدةً بالزّوالِ، وهذا مظهرٌ من مظاهرِ غُرْبَتِها بين أبنائها وذويها. اللغة والحضارة الإسلامية: كانَ البدْءُ (بَدْءُ النُّبُوَّةِ) بِتَعْليمِ الكَلِمَة: { وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّهَا...}([1])، والخَتْمُ (خَتْمُ النُّبُوَّةِ) بِتَعْليمِ الكَلِمة: { اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ }([2]). وأَخْرَجَ الإِمامُ أَحْمَدُ من حديثِ عَمْرو بْنِ العاصِ رضيَ الله عنه قالَ: «خَرَجَ عَلَيْنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوْمًا كالمودِّعِ فقالَ: أنا مُحمَّدٌ النّبِيُّ، [ثلاثَ مرّاتٍ] ولا نبيَّ بعدي، أوتيتُ فواتِحَ الكلِمِ وخَواتِمَه وجوامِعَه ...»([3]). فالوَحيُ نَزَلَ كَلِمةً، فكانَ بهذه الكلمةِ مَصْدرًا من مَصادِرِ العِلْمِ والمعرِفةِ. وحدّثَ محمّدُ بنُ رافعٍ والفضلُ بنُ سهلٍ الأعرج عن شبابةَ بنِ سوار بنِ عاصِمٍ عن أبيه عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنّه قالَ: « إنّ الإسلامَ بدأَ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأَ، وهو يأْرِزُ([4]) بينَ المسجدينِ كما تأرِزُ الحيّةُ في جُحرِها»([5]). الإسلامُ هوالعُمقُ الحَضارِيّ للغةِ العربيّة، تُصابُ بِما يُصابُ به الدّينُ من انتشارٍ أوانحِسارٍ، وبِما يَعْتَريه من غربة أو ازْدِهارٍ، فمن المعروفِ أنّ اللّغةَ العربيّةَ انتشرَت بانتشارِ الإسلامِ وامتِدادِ فتوحاتِه في إفريقيا وآسيا، وكانَ لها من القوّةِ والنّفوذِ ما مكَّنَها من التّغلُّبِ على لُغاتِ الأمصارِ القديمةِ. ويرجعُ تمكُّنُها إلى بنيتِها الدّاخليّةِ ودقّةِ نظامِها وقواعِدِها وغِنى معجمِها، وإلى آدابِها وتُراثِها الذي يؤسِّسُها، وعلى رأسِ الثّقافةِ التي تُسْنِدُها القرآنُ الكريمُ والحديثُ النّبويُّ الشّريفُ ببلاغتِهِما المعجِزةِ، ويرجعُ تمكُّنُها كذلك إلى قدرتِها على التّعبيرِ والإبانةِ عن مختلِفِ جوانِبِ الفكرِ والوجدانِ، ومن أسبابِ تمكُّنها أيضًا صلتُها بالإسلامِ؛ فهي لُغةُ مصادِرِ التّشريعِ ولُغةُ التّعبُّدِ؛ يقولُ الإمامُ الشّافعيّ: «ولِسانُ العربِ أوسعُ الألسنةِ مذهبًا وأكثرُها ألفاظًا، ولا نعلمُه يُحيطُ بجميعِ علمِه إنسانٌ غير نبيٍّ [...] والعلمُ به عندَ العربِ كالعلمِ بالسّنّةِ عندَ أهلِ الفقهِ، لا نعلمُ رجُلاً جَمَعَ السُّنَنَ فلم يَذهبْ منها عليه شيءٌ [...] وهكذا لسانُ العربِ عندَ خاصّتِها وعامّتِها، لا يذهبُ منه شيءٌ عليها ولا يُطلبُ عندَ غيرِها، ولا يعلمُه إلاّ مَن قبِلَه منها، ولا يشركُها فيه إلاّ مَن اتَّبَعها في تَعلُّمِه منها، ومَن قبِلَه منها فهو من أهلِ لِسانِها، وإنَّما صارَ غيرُهم من غيرِ أهلِه بتركِه، فإذا صارَ إليه صارَ من أهلِه، ومن نطَقَ بقليلٍ منه فهو تَبعٌ للعربِ فيه، فعلى كلِّ مسلِمٍ أن يتعلّمَ من لسانِ العربِ ما بلغَه جهده، حتّى يشهدَ به ألاّ إله إلاّ اللهُ وأنّ محمّدًا عبدُه ورسولُه، ويَتْلُوكتابَ الله، وينطِقَ بالذِّكرِ فيما افتُرِضَ عليه من التّكبيرِ، وأُمِرَ به من التّسبيحِ والتّشهّدِ وغيرِ ذلك [...] فكانَ تنبيه العامّةِ على أنّ القرآنَ نزلَ بلِسانِ العربِ خاصّةً نصيحَةً للمُسْلِمينَ، والنّصيحةُ فرضٌ لا ينبغي تركُه، وإدراكُ نافلةٍ لا يدَعُها إلاّ من سَفِه نفسَه وترَك موضِعَ حظِّه »([6]). ويقولُ ابْنُ تيميةَ رحمه الله: «ومَعلومٌ أنّ تعلُّمَ العربيةِ فرضٌ على الكِفايةِ، وكانَ السّلَفُ يؤدِّبونَ أولادَهم على اللّحنِ، فنحنُ مأمورونَ أمرَ إيجابٍ أوأمرَ استحبابٍ أن نَحفظَ القانونَ العربيَّ، ونُصلِحَ الألسنةَ المائلةَ عنه، فيحفظ لنا طريقة الكتابِ والسّنّةِ والاقْتِداءِ بالعربِ في خِطابِها»([7]). وقد ذكرَ ابنُ تيميةَ أنّ اللسانَ العربيَّ شعارُ الإسلامِ وأهلِه، واللّغات من أعظمِ شعارِ الأممِ التي بها يتميّزونَ([8]). لقد انتشرتِ اللّغةُ العربيّةُ بذاتِها وبعاملِ الدّينِ. وقد ذكرَ لنا الشّافعيُّ عاملَ الإسلامِ في تمكُّنِها، وتتحدَّثُ الأخبارُ عن قدرتِها على الانتشارِ؛ حيثُ إنّ اتّصالَها بالتّراثِ العلميِّ القديمِ بدأَ منذ القرنِ الأوّلِ في حركةِ ترجمةٍ لكُتُبٍ في النّجومِ والفَلَكِ والطّبِّ والكيمياءِ، برِعايةِ خالِد بْنِ يزيدَ بنِ معاويةَ الأمويِّ، وما زالتِ العربيةُ في اتّصالِها بالعُلومِ إلى أن اتّخذت في العصرِ العبّاسيِّ وضعًا رسميًّا. هذا وقد انطلقَ العُلماءُ المسلمونَ يتأمّلون في الظّواهرِ الكونيّةِ بعقليةٍ متحرِّرةٍ من الخُصومةِ القديمةِ بين العقلِ والدّينِ، التي عرَفها التّراثُ العلميُّ اللاّتينيُّ؛ حيثُ كانت الكنيسةُ تتدخّلُ لتُحرِّمَ وتُحلِّلَ، حتّى انتهى المطافُ اليومَ بالكنيسةِ والمجتمعِ الغربيِّ إلى إسقاطِ وصايةِ الدّينِ، وكلُّ ذلك لم يُعْرَفْ في تاريخِ المُسْلِمينَ ولا في دينِهم؛ لأنّهم نظّموا حياتَهم العلميّةَ والاجتماعيّةَ والسّياسيّةَ بالدّينِ، فظهروا على الأممِ الأخرى . ولابدَّ من الإشارةِ هنا إلى أنّ العربيّةَ لم تعتمدْ في انتشارِها على السّلطةِ الحاكمةِ، كما تصوّرَ بعضُ الدّارسينَ فيما سمّوه بسلطانِ اللّغةِ الغازِيَةِ، والدّليلُ على ذلكَ أنّ العربيّةَ ما زالتْ قائمةً فينا بالرّغمِ من خضوعِ سائرِ بلادِ العربِ لحالةِ الاستعمارِ سنينَ عددًا. ولولا أنّ العربيّةَ صالحةٌ في ذاتِها للاستمرارِ والمواكبةِ لانحصرت في نطاقِ التّعبُّدِ والأحكامِ الفقهيّةِ، أو في مجالِ السّلطةِ السّياسيّةِ ... لقد وصلت إلينا اللّغةُ العربيّةُ في تُراثِ الجاهليّةِ مهذّبةً مصقولةً حتّى بلغت مستوى عاليًا من الدّقّةِ، دقَّةِ الدّلالةِ وإحكامِ الصّياغةِ والعبارةِ، استطاعَ معه العلماءُ في عصرِ التّدوينِ وما بعدَه أن يستخلِصوا من تُراثِ الفصحى قواعِدَ النّحووالصّرفِ، والاشتقاق والوضع، وضوابِطَ العروضِ، وأساليبَ البيانِ. وصلت إلينا وقد أهملتِ الحوشيَّ والغريبَ والمُسْتثقَلَ، وهذّبت صيَغها بالإعلالِ والإبدالِ والقلبِ والإدغامِ والحذفِ، وما زالت أسرارُ العربيّةِ محجوبةً، وما زالَ الميدانُ متّسِعًا لاكتشافِ الجديدِ في دلالاتِ الألفاظِ في النّصوصِ المختلفةِ، وعلى رأسِها القرآنُ الكريمُ. ومن المُفيدِ أن يتساءَلَ المرءُ: كيفَ تأتّى لِلُغَةٍ عاشت في بيئةٍ بدويّةٍ صحراويّةٍ معزولةً عن غيرِها من اللّغاتِ أن تتضمّنَ طاقاتٍ هائلةً من التّعبيرِ؟ والجوابُ أنّها استطاعت أن تتفوّقَ في التّعبيرِ والانتشارِ والظّهورِ على كثيرٍ من اللّغاتِ واللّهجاتِ؛ لأنّها تضمّنت الضّوابطَ والقوانينَ التي مكَّنتْها من التّطوُّرِ والمُواكبةِ، ومن التّوليدِ والتّفريعِ والتّعبيرِ في مختلِفِ المجالاتِ والمقاماتِ، إنّها قوانينُ نمو اللّغةِ، وهذه القوانينُ هي القِياسُ والاشتقاقُ والقلبُ والإبدالُ والنّحتُ والارْتِجالُ... أمّا ما يُثارُ من شُبُهاتٍ معاصرَةٍ حولَ اللّغةِ العربيّةِ مثل شبهةِ «اللّغة الدّينيّة»([9]) في مقابلِ «اللُّغةِ العصرِيّة»، وشبهةِ «الجُملة القرآنيّة» في مُقابلِ «الجُملةِ الإنجيليّة»([10]) فمصدرُه الاستعمارُ الذي وجَد النّاسَ يحفظونَ القرآنَ الكريمَ منذ طفولَتِهم وإن لم يفهموه ولم يتّخذوه لِسانَهم، فظنّوا أنّ الفصحى لغةٌ دينيّةٌ، مثلما عدّوا اللّغةَ اللاّتينيّةَ لغةً دينيّةً، وكأنّه لا يقترِن بالدّينِ إلاّ كلُّ ما آلَ أمرُه إلى الموتِ والزّوالِ، فعمِلَ الاستعمارُ منذ استيلائه على بلادِ العربِ على الاستهانةِ بالعربيّةِ وتنزيلِها منزلةَ الأجنبيّةِ في عُقرِ دارِها، تُدَرَّسُ في غربةٍ شديدةٍ على نفوسِ النّاشئةِ، ويُدفعُ بها إلى الانحِلالِ والتّراجعِ، ولكنّ اجتهادَ الاستعمارِ منذ دخولِه وما أثمرَه من ثمارِ التّمكينِ لثقافتِه ولغتِه على حسابِ لغةِ البلادِ العربيّةِ وثقافتِها، لا ينبغي أن يثنِيَ العزائمَ، بل يجبُ أن يكونَ حافزًا للعودةِ إلى إحياءِ اللّغةِ والذّاتِ والرّجوعِ إليها والاعتقادِ الجازمِ بأنّ الأمّةَ تمرُّ من امتحانِ الغربةِ في اللّغةِ، مثلَما مرّت وما زالت تمرّ من امتحانِ الغربةِ في الدّين. ونعودُ إلى الحديثِ عن صِلةِ اللّسانِ بالحضارةِ الإسلاميّةِ، فكثيرًا ما يتحدّثُ الباحثون عن علاقةِ اللّغةِ بالفكرِ، وتأثيرِ الحضارةِ في اللّغةِ وتأثّرِها بها، وليست اللّغةُ العربيّةُ بدعًا من سائرِ اللّغاتِ في هذا الشّأن؛ فقد كان لها نصيبٌ غير يسيرٍ من التّأثّرِ بالحضارةِ العربيةِ الإسلاميّةِ والتّأثيرِ فيها، وعُرفَ عن العربِ منذ القديمِ اعتزازُهم بلُغَتِهم، وشعورُهم بتفوّقِها وقدرتِها على التّعبيرِ عن أغراضِهم ومستجدّاتِ حياتِهم الاجتماعيّةِ والعَقَديّةِ والعلميّةِ، وكانَ هذا مظهرًا من مظاهرِ تحضّرِ النّاطقينَ بالعربيّةِ لأنّهم كانوا يصوغونَ خيوطَ أنماطِ حياتِهم بنسيجٍ عربيّ خالصٍ، ولا يعتمدون على أنماطٍ أخرى أجنبيّةٍ عنهم إلاّ على سبيلِ الاستفادةِ والتّفاعلِ لا الهيمنةِ والغزوِ. بل يعدُّ انْتقالُ العربِ من الجاهليّةِ الضّيّقةِ إلى حضارةِ الإسلامِ الواسعةِ أكبرَ عاملٍ من عواملِ نهضةِ لغتِهم ورُقِيِّ أساليبِها واتِّساعِها لمختَلِفِ أَنْماطِ التَّعبيرِ، وأهمَّ سببٍ من أسبابِ تهذيبِ لُغَتِهم وسمُو أساليبِها واتِّساعِ نِطاقِها وتخلُّصِها ممّا عسى أن يكونَ بها من خُشونةٍ وغرابةٍ([11]). وعندما أصيبَ المجتمعُ العربيّ الإسلاميّ بصدماتِ الغزو والاستعمارِ المتتاليةِ تراجعت قدُراتُه الإبداعيّةُ ومهاراتُه اللّغويّةُ([12])، وتفكّكت الأواصرُ التي كانت تشدّ اللّغةَ بالحضارةِ، فتخلّى المتكلّمونَ عن التّعبيرِ عن أنماطِ حياتِهم، واستعاروا لغاتِ الغزاةِ، وأكبّ الباحثون على مناهجِ البحثِ اللّغويّ في اللّغاتِ الأجنبيّةِ وأخذوا يطبّقونها على لهجاتهِم اليوميّةِ، حتّى باتَ متداوَلاً عندهم أن العلومَ والمعارفَ تتطوّرُ في كنفِ اللّغاتِ الأوربّيةِ فقط، أمّا اللّغةُ العربيّةُ فقد احتفظوا لها بصفةِ التّعبيرِ عن التّقاليدِ والأصالةِ والذّاتِ لا غير؛ لأنّها بزعمِهم عاجزةٌ عن التّعبيرِ عن أنماطِ الحياةِ الجديدةِ التي تفرِضها المدنيّةُ الغربيّةُ على العالَم. هكذا نظروا إليها! بينما هي في حقيقةِ الأمرِ غريبةٌ في بيئتِها وبين أبنائها، ولا يمضي يومٌ في مسارِ التّفوّقِ الغربيّ على الأصعدةِ المختلفةِ إلاّ وتزدادُ العربيّةُ معاناةً من الإهمالِ؛ فهي تعاني من انصرافِ المتكلّمينَ العربِ إلى اللّغاتِ الأجنبيّةِ بدعوى أنّها لغاتُ الانفتاحِ على العالَم، وانصرافِ طائفةٍ أخرى إلى لهجاتٍ إقليميّةٍ لإحياءِ ثقافاتٍ محلّيّةٍ، وانصرافِ طائفةٍ ثالثةٍ إلى اللّهجةِ العامّيّةِ الدّارجةِ بدعوى أنّها لسانُ الخطابِ الشّعبيّ والتّداولِ اليوميّ. وهذا وضعٌ غيرُ مُريحٍ فُرِضَ على اللّغةِ العربيّةِ في العالَم العربيّ، بل فُرضَ عليها صراعٌ لغويٌّ مريرٌ بينها وبين تلك اللّهجاتِ واللُّغَيّاتِ، وهوصراعٌ غريبٌ عنها أحدثته فئةٌ اجتماعيّةٌ تنتفعُ من هذا الصّراعِ وتقتاتُ عليه؛ لتنتعشَ مشاريعُ لها وبرامجُ وتصوّراتٌ ضيّقةٌ على حسابِ المشروعِ العربيّ الفصيحِ، أي إنّ تعويضَ العربيّةِ الفصيحةِ بالأجنبيّةِ أوالعامّيّةِ أواللّهجةِ المحلّيّةِ يُفضي إلى نقضِ عُرى الأمّةِ وذهابِ هويتِها، وهوصراعٌ مريرٌ([13]) - كذلك - لأنّ العربيّةَ لم تتنازلْ إلى يومِنا هذا عن حقّها في الوجودِ ومكانتِها في التّعبيرِ عن الثّقافةِ والعلمِ ووجدانِ الأمّةِ وعقيدتِها، ويكمنُ سرُّ تلك المقاومةِ في أنّ عمومَ المتكلّمينَ العربِ، ما زالوا متمسّكينَ بالأساسِ الدّيني والحضاريّ للعربيّةِ الفصحى، ولوتركوا هذا الأساسَ لضاعت العربيّةُ ولتلاشت أجزاؤُها، مثلما تلاشت اللاتينيّةُ لفائدةِ لهجاتٍ أوربّيةٍ أصبحت تُدعى فيما بعد لُغاتٍ حيّةً. ويَتّخذُ هذا الصّراعُ في أجزاءِ الوطنِ العربيّ الكبيرِ شكلينِ مختلفينِ، وذلك بحسبِ انفتاحِ هذا البلدِ أوذاكَ على المؤثّراتِ الأجنبيّةِ الوافدةِ أو ضعفِ انفتاحِه عليها؛ فكلّما ازدادَ هذا الانفتاحُ في بلدٍ عربيّ ما ضعفت ملَكةُ أهلِه -على تفاوتٍ بينهم- في أداءِ العربيّةِ الفصيحةِ، وتفاقمت مظاهرُ الازدواجيّةِ والثّنائيةِ اللّغويّةِ في المحاوراتِ، وساعدَ هذا الانفتاحُ وتلك الازدواجيّةُ على الانسلاخِ المتدرّجِ من المجتمع، وعلى التّطلّعِ إلى المجتمعِ الأجنبيّ وعَدِّ من لم يكتسبْ لغةَ الأجنبيّ وعاداتِه ومعارفَه جاهلاً يفتقرُ إلى أسبابِ التّقدّمِ والحداثةِ، فأصبحَ مقياسُ التّقدّمِ هوالتّجرّد من صفاتِ الذّاتِ وأصولِها وتقمّص خصائصِ الآخَرِ ولغتِه ومعارفِه وعاداتِه ... ولا نتحدّثُ هنا عن غبطةِ هذا الأجنبيّ بهذا الاتّباعِ، بل اجتهادِه في ترسيخِ هذا الوضعِ ؛ حتّى يصبحَ العالَمُ العربيّ بعاداتِه ومنتجاتِه ولُغاتِه سوقًا لعرضِ سِلَعِ الأجانبِ ولغاتهم ومدنيّتِهم. وهكذا أدّى هذا الازدواجُ اللّغويّ القهرِيُّ إلى تصدُّعِ وحدةِ الأمّةِ الاجتماعيّةِ، وتمزيقِها إلى طبقاتٍ ثقافيّةٍ وعقليّةٍ، «وبهذه الوحدةِ المرْضوضةِ الواهنةِ تُمارِسُ الحياةَ العمليّةَ وهي خائرةُ التّماسكِ، فاترةُ التّعاونِ»([14]). هكذا ألْفَت العربيّةُ الفصحى نفسَها مُهْمَلَةً مُلقاةً في رُفوفِ المكتباتِ ورِحابِ الجامعاتِ والمجامعِ العلميّةِ والأكاديميّاتِ، وفي بطونِ الكتبِ القديمةِ، فتراجعت قدراتُ المتكلّمينَ اللّغويّةُ وملَكاتُهم الفصيحةُ، وانعكسَ كلُّ ذلكَ على مستوى التّعليم وعلى كلِّ ما يترتّبُ على التّعليمِ من تنميةِ القدراتِ العقليّةِ والمهاراتِ اللّغويّةِ، ومِن تزويدِ المتكلّمِ بملَكةِ التّواصلِ اللّغويّ السّليمِ وتداولِ الخبراتِ والمعلوماتِ والمعارِفِ بصورةٍ صحيحةٍ. ويظهرُ أثرُ إهمالِ العربيّةِ الفصحى وسحبِها من دواليبِ الحياةِ ومراكزِ الفكرِ والفعلِ والقرارِ، في أنماطِ الأخطاءِ التي يرتكبُها التّلاميذُ والطّلاّبُ في جميعِ مستوياتِهم الدّراسيّةِ، ويتلقَّفونها من أنماطِ التّعبيرِ والأساليبِ المُلَقَّنَةِ، ويستعيرونها من اللّهجاتِ السّائدةِ. أ- بين اللّسانِ العربِيّ والعِلْم: لا يُخالِفُ عاقلٌ في فضلِ العلم وجليلِ مَحلِّه، فهو على رأسِ الفَضائلِ، وأحقُّها بالتَّقديمِ، وأسبقُها في استيجابِ التَّعظيم، وهوالسّبيلُ إلى خيرِ المنازلِ، والدَّليلُ على كلِّ الفضائلِ، وذروةُ المناقبِ وسنامُها، ولولاه لَما بانَ الإنسانُ من سائرِ الكائناتِ إلاّ بالصّورةِ والهيئة. هذا، ولقد أصبحَ في زَمانِنا مهْجورًا مَزْهودًا فيه، حيثُ أصغَرَ النّاسُ أمرَه وتَهاونوا فيه، فأصبحَ يُعاني غُرْبةً وقلَّةً، نبَّه عليها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم، حين قالَ في الحديثِ الذي رواه إسماعيلُ بنُ أَبي أُوَيْس عن مالكٍ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص: « إن الله لا يقبض العِلْمَ انتزاعًا ينتزِعُه من العبادِ، ولكن يقبضُ العلمَ بقَبْضِ العلماءِ حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذَ النّاسُ رُؤوسًا جُهّالاً فسُئِلوا فَأَفْتَوْا بغَيْرِ عِلْمٍ فضَلّوا وأضَلّوا»([15]). فأكثرُ النّاس في هذا الزّمانِ ناكبون عن سبيلِ العلمِ، متطيِّرون من اسمِه، متضايقون من أهلِه، والنّاشئُ منهم راغبٌ عن التّعليمِ، والشّادي تاركٌ للازديادِ منه، والعُلَماءُ غُرَباءُ في ديارِهم، مغمورون بين ذويهم وعِتْرَتِهم، وسوقُ الجهلِ والدّنيا في تنامٍ وازديادٍ، وسوقُ العلمِ قد أصابَها الكسادُ، لقلّة عنايةِ أهلِه بحفظِه، والبواعثُ إليه قلّت، والحوادثُ الصّارِفاتُ عنه عظُمت وجلَّت . هذا، وإنّ النّكبَةَ التي حلّت في زمانِنا بالعلمِ هي «تَناقُصُ أطرافِه وفُشُو أَدَواتِه»: ذلك أن المدنيّةَ المعاصرةَ كلّما تقدّمت ازدادت اكتشافًا للوسائلِ والأدواتِ التّقنيّةِ المتطوِّرةِ التي صُنِعت لنشرِ العلومِ وإذاعةِ المعارِفِ، وسهّلت على الإنسانِ سبُلَ الحياةِ، ويسّرت له اليومَ ما كانَ بالأمسِ عسيرًا. فقد شهدَ هذا العصرُ دفقةً واسعةً في وسائلِ اللّقانةِ([16]) والتّعليم، لم تترُكْ صغيرةً ولا كبيرةً في ميادينِ البرامجِ والمناهجِ وطُرُقِ التّبليغِ والتّبسيطِ إلاّ ارْتادَتْها؛ فقد تنوّعت هذه الوسائلُ تنوُّعًا لافتًا، حيثُ ضمّت الكتبَ والمجلاّتِ والحواسيبَ والمُلْصقاتِ والإعلاناتِ والألعابَ الهادفةَ والمنبِّهاتِ المثيرةَ للحواسِّ، ووضَعَت الرّوائزَ وامتحنت المتعلِّمَ وحَمَلَتْه على سرعةِ الاهتِداءِ وحسنِ الجوابِ ... أجَل، ما عَرَفَ العالَمُ مرحلَةً كثُرت فيها الوسائلُ لنقلِ المعلوماتِ والمَعارِفِ، كالمَرحلَةِ التي هو فيها، ولوتأمَّلْتَ قيمةَ المعارِفِ والعُلومِ التي تتلقّاها الأجيالُ النّاشئةُ اليومَ، لوجدْتَ أنّها معارفُ ضعيفةٌ مُعَرَّضَةٌ للنّسيانِ والضَّياعِ، مطبوعةٌ بالعجَلَةِ والسّطحيّةِ، مَشروطةٌ بالمُنبِّهات، وإذا قُدِّرَ لك أن تُحاورَ شبابَ اليومِ، لوجدتَ كثيرًا منهم -في الأغلبِ الأعمِّ- مفتقِرينَ إلى أدبيّاتِ الحوارِ وطرُقِ المناظرةِ وطولِ النَّفَس ومنهجِ الإقناع والتّسلسُل المنطقيّ... وهي أمورٌ كانت منتشرِةً يومَ لم تكن هذه الوسائلُ الهائلةُ مُتَوافرةً، فلمّا اندفعَ سيلُ المُخترَعاتِ والتّقنيّاتِ التّلقينيّةِ قلَّ العَطاءُ وتراجعتِ القُدُراتُ، وتخرّجَ على مدرسةِ التّقنيّاتِ الحديثة جيلٌ مُرهَقُ الفكْرِ مُنهَك الحواسِّ، أتعبَتْه المنبِّهاتُ وبات يلتمِسُ مطلوبَه في الألعابِ المسلِّيَة والأنشطةِ المروِّحة. ولا شكّ أنّ السّببَ في ذلك كلِّه أنّ العلومَ والمعارِفَ أُفْرِغت من مضمونِها وجُرِّدت من مكْنونِها، فأصبحت أصنافُه ومُصَنَّفاتُه كثيرةً ونُكَته قليلة، وأنواره ساطعة وثماره عزيزة، وما ذلك إلاّ لأنّ العلمَ فُصلَ عن مكارمِ الأخلاقِ، وأصبحَ المدرِّس مُجرَّد ملقِّنٍ للتّلميذ لا يختلفُ حالُه عن حالِ الآلاتِ المُلقِّنةِ التي تُؤمرُ فتستجيبُ، وأصبحَ التّلميذُ موكولاً إلى نفسِه وهو يتعلّمُ ويتلقّى، وفُصلت هذه المعارفُ عن التّربيةِ والتّوجيه وخُلُق الانضباطِ والاستِماعِ. ولا تسأل عن آثارِ هذه المناهجِ العلمانيّةِ الفاصِلة في المجتمعِ برُمّتِه، وما تزوِّده به من ظواهرَ تربويّةٍ غريبةٍ، تطبعُها السّطحيّةُ والعَجَلَة، وتفتقِر إلى من يُسيرُ أمورَها ويقضي مآرِبَها ويأخذُ بيدِها، ولكنّها أُعْطِيَت زمامَ تسييرِ الشّؤون العامّةِ، وحُمِّلت المسؤوليّاتِ الجِسامَ، فكانت وبالاً على البلادِ والعبادِ. ورأسُ الدّاءِ كلِّه هو «فُشُو مُريعٌ لأدواتِ العلمِ، وتَناقُصٌ لأطرافِه» لمّا فُصل عن مرجعيّتِه العَقَديةِ والخلُقيّة. فليس النّقصُ في وسائلِ نشرِ المعرفةِ، ولكنّ النّقصَ في طبيعةِ المعرفةِ ذاتِها وما ينبغي أن ترميَ إليه من إعادةِ تشكيلِ الإنسانِ وفقَ أصولِه الحضاريّةِ الأولى، ثمّ ما يفرِضه العصرُ من تحدٍّ ومواجهةٍ، ومن حربٍ حضاريّةٍ كونيّةٍ، و"عَوْلَمَةٍ" تمتصُّ خُصوصيّاتِ الأُمم وثقافتَها، وتُلْقي بها في يَمِّ التّمييعِ والتّضييعِ، فتَصْهرُ عناصر القوّةِ في كلِّ ثقافةٍ، وتَشُلُّ قُدْرَتَها عن كلِّ تأثيرٍ وغَلَبَةٍ وتَوْجيهٍ، فتَحْرِمُها من إفادةِ الثّقافاتِ الأخرى بتجاربَ إنسانيّةٍ خاصّةٍ يُمْكِنُ أن تُنْتَقى وتصيرَ نافعةً في حياةِ الأُمم والحضاراتِ. فمن المعلومِ أنّ النّظامَ الدّوليّ الجديدَ صيغةٌ تفتقرُ إلى نظامٍ، ونظريّةٌ في التّحضُّرِ تفتقرُ إلى حضارةٍ مؤطِّرةٍ، وجَسدٌ يفتقرُ إلى روحٍ، وصيغةٌ ذاتُ نظامٍ موهومٍ ألقِيَ بِها في دُنْيا النّاسِ لابْتِلاعِ الثَّقافاتِ القوميّةِ والْتِهامِ كلِّ الثّوابِت، وطوفانٌ جائحٌ يُهدِّدُ بإغراقِ كلَّ شيءٍ، لأنّه عُنْوانٌ على «الزّمَنِ الجديد» الذي وصَلَ إلى مرحلةٍ يضيقُ عندَها بالاخْتلافِ والتّنوُّع([17]). هذه هي العقبةُ الكأْداءُ التي ينبغي أن تقتحمَها المعرفةُ في الوقتِ الرّاهنِ، وهذا هوالتّحدّي الذي تُواجهُه وهي تلتمسُ طريقَها إلى عُقولِ النّاسِ وقُلوبِهم، مُؤَزَّرَةً بإطارِها الحضاريِّ ومذهبِها العقَدي وتصوُّرِها السّليمِ الذي يربطُ العلمَ بأساسِ الأخلاقِ والإيمان العربيّةُ ومؤامرةُ التّغريب: مضت العربيّةُ حقَبًا طويلةً تخدم التّواصلَ والفكرَ والعلمَ والدّينَ، إلى أن اصطدمت بحملاتِ المؤامرةِ. والمؤامرَةُ على العربيّةِ قديمةٌ قِدمَ المؤامرةِ على الدّينِ، وقد لبست في بعضِ حلقاتِها ثوبَ البحثِ العلميِّ، وهي صورةٌ خادعةٌ تجدُ لَها ممّن يُلمُّ بخيوطِ المؤامرةِ استِجابةً ساذجةً. ومن المعروفِ أنّ العربيّةَ كانت منحصِرَةً في شبهِ الجزيرةِ قبلَ الإسلامِ، ثمّ بدأت تنتشرُ معه في كلِّ اتّجاهٍ، واصطرعت مع لُغاتٍ كثيرةٍ أثّرت فيها وتأثّرت بِها بعضَ التّأثُّرِ، ولكنّها سادت وعمّت، وهي الآنَ تواجه صراعًا شديدًا بسببِ ظهورِ جديدِ الحضارةِ والعلمِ الذي يفرِضُ على العربيّةِ أن تستوعِبَه، وبسببِ وجودِ لغاتٍ تُنازِعُها البقاءَ، بعضُها محلّيّ وبعضُها أجنبيٌّ، ولا بدَّ أن تُقاوِمَها وتظهَرَ عليها، وهي مُطالَبَةٌ بأن تتفوّقَ على اللّغاتِ واللّهجاتِ، وتعبِّرَ عن الحضارةِ والعِلم، وأن تستعيدَ دورَها في إطارِ الجامِعةِ الإسلاميّةِ بعدَ أن سَلَبَتْها إيّاه الجامعةُ اللاّتينيّةُ، وذلكَ بأن تستعيدَ مكانَتَها على ألسنةِ المسلِمينَ ونمطِ تفكيرِهم. لقد كانت العربيّةُ ركنًا من الأركانِ التي قامَ عليها نظامُ الحضارةِ الإسلاميّةِ بمفاهيمِه ومصطلحاتِه ودلالاتِه، قبلَ أن يتمَّ السّطو على المُصطلَحاتِ وتحريفُها عن مواضعِها لتزييفِ الحقائقِ وقطعِ التّواصلِ بين النّاطقينَ بها، وهي مُطالَبةٌ بأن تتفوّقَ على اللّغاتِ الأجنبيّةِ وتحلَّ محلَّها بالتّعريبِ والتّرجمةِ وملاحَقةِ المُستجدّاتِ باطّرادٍ، لا أن تظلَّ لغةَ "الأصالةِ" فحسبُ - كما زعموا لها - وتترك للأجنبيّةِ أن تكونَ لغةَ التّقدّمِ والتّفتّحِ، إنّها مُطالَبَةٌ أن تكونَ لغةً أصيلةً متطوِّرةً حتّى نتمكّنَ من التّفكيرِ بها، فيتوحّد أسلوبُ التّفكيرِ لدى ملايينِ المسلِمينَ بتوحيدِ أسلوبِ التّعبيرِ عندهم. وهي مطالبةُ - كما أسلفنا القولَ - بأن تتفوّقَ على العامّيّاتِ؛ لأنّ العامّيّاتِ جاوزتِ الحدَّ الذي يجبُ أن تقفَ عندَه؛ فمن الطّبيعيّ أن نجدَ في جلِّ اللّغاتِ ازدواجيّةَ "اللّغةِ المكتوبةِ" و"اللّغةِ المنطوقة"، ولكنّ المشكلَ هو أن تُزاحمَ العامّيّاتُ اللُّغَةَ الفصحى على ألسنةِ النّاطقينَ وفي وسائلِ الإعلامِ... ولقد استمرَّ الأمرُ كذلِك حتّى أصبحنا نسمعُ دفاعًا عن العامّيّاتِ والدّوارِجِ واللّهجاتِ المحلّيّةِ، بدعوى أنّها اللّغةُ المحكيّةُ ولغةُ الخطابِ اليوميِّ ولغةُ الواقعِ([18])، وأنّ العربيّةَ لغةٌ كلاسيكيّةٌ لم تعدْ تَفي بمطالبِ الواقعِ المتطوِّرِ . وقد صادف هذا الصّراعُ والتّمكينُ للعامّيّاتِ واللّهجاتِ مشكلةً أخرى مكّنت لها وزادتها رسوخًا في المجتمعاتِ العربيّةِ وفي أوساطِ القُرّاءِ، وهي توقُّفُ القارِئِ عن متابعةِ النّصوصِ العربيّةِ الجيّدةِ، وفرضت مناهجُ التّدريسِ نصوصًا معيّنةً على المتخصِّصينَ، بعيدةً عن ميولِهم وأذواقِهم، فرْضًا، ولم تُراعِ هذه المناهجُ أهمّيّةَ إثارةِ حبِّ الأدبِ والنّصوصِ في نفوسِهم والتّعاطُفِ معها، ففرَضَت عليهم بذلك غُربةً أدبيّةً وتاريخيّةً جعلت النّصوصَ عندهم مجرّدَ وثائقَ تاريخيّةٍ أوفنّيّةٍ، وهذا جزءٌ من المُعاناةِ التي تعرِفُها الحضارةُ الإسلاميّةُ. تقولُ الأستاذة عائشةُ عبد الرّحمن: «ليست عُقْدَةُ الأزمةِ في اللّغةِ ذاتِها؛ العُقدةُ - فيما أتصوّرُ - هي أنّ أبناءَنا لا يتعلّمونَ العربيّةَ لسانَ أمّةٍ ولغةَ حياةٍ، وإنّما يتعلّمونَها بمعزلٍ عن سليقتِهِم اللّغويّةِ: قواعدَ صنعةٍ وقوالِبَ صمّاءَ، تُجهِد المعلّمَ تلقينًا والتّلميذَ حفظًا، دونَ أن تُكسِبَه ذوقَ العربيّةِ ومنطقَها وبيانَها»([19]). إنّ وجودَ لغةٍ عُليا للفكرِ والأدبِ والعلمِ، مع لهجاتٍ محلّيّةٍ للتّعاملِ، ظاهرةٌ طبيعيّةٌ عرفتها العربيّةُ منذ قديمها الجاهلِيِّ، وتعرِفُها الدّنيا في سائرِ اللّغاتِ الحيّةِ([20]). ولهجاتُ العربيّةِ عايشت الفصحى ولم تَجُرْ عليها، فظلّت اللّغةُ العربيّةُ لغةَ الدّينِ والدّولةِ والعلمِ والتّعليمِ إلى يومنا هذا، وظلّت جامعةً تجمعُ بين المسلمينَ على اختِلافِ أجناسِهم وألوانِهم وأقطارِهم. وإذا كان هناك من مُفاضلةٍ بين فصيحةٍ وعامّيةٍ فَلِمَ يُدْعى المتكلِّمونَ إلى اختيارِ الأدنى وتركِ الأعلى الذي في بقائهِ بقاءٌ للقرآنِ الكريم ؟ لكنّ الاستعمارَ استغلَّ هذه الظّاهرةَ الطّبيعيّةَ ليُحاربَ العربيّةَ الفصحى، بلهجاتِها الشّعبيّةِ للوصولِ إلى تمزيقِ نسيجِ الأمّةِ وفكِّ وحدةِ اللّغةِ والمزاجِ والفكرِ والفعلِ، وليجعلَ من الأمّةِ الإسلاميّةِ عقليّاتٍ متضاربةً بدلاً من عقليّةٍ واحدةٍ. وهكذا ارتبطت العامّيةُ بالوجودِ الاستعماري الفرنسيّ والإنجليزيّ والإسباني، عندما صارت سلاحًا ضدّ العربيّةِ الفصحى تُناصبُها العداءَ، وانطلقت حملاتُ الاستعمارِ في المغربِ والمشرِقِ تكشفُ عن "جمودِ" الفصحى و"تخلُّفِ" أصحابِها، وتدعوللعامّيّةِ لأنّها قريبةٌ من الأمّيّين ولُيُسْرِ أدائها - بزعمهم - مثلما تدعو للغةِ المستعمِرِ في التّعلُّم والتّقدّمِ. وقد كانت الجزائر، بحكم سبقِ الاستعمارِ إليها، حقلَ التّجربةِ في غزوالاستعمارِ لغربِ العالمِ الإسلاميّ، وكانت مصرُ مجالاً للغزو في مشرقِ البلادِ الإسلامية؛ ففي سنة 1893 م ألقى المهندس الإنجليزيّ "ويلكوكس" محاضرةً في مصر دعا فيها إلى إحلالِ العامّيّةِ محلَّ الفصحى في الكتابةِ والتّأليفِ، وكانَ موضوعُها هوالتّساؤل: لِمَ لَمْ توجدْ قوّةُ الاختراعِ لدى المصريّين إلى الآن؟ وكانَ جوابُه طبعًا: أنّ العربيّةَ الفصحى- ولا شيءَ غيرُها - هي التي أماتت فيهم قوّةَ الاختِراعِ فيهم، ولا أملَ في إحيائها إلاّ باتّخاذِ العامّيّةِ بدلاً منها. ولا ننسى هنا ما ذهب إليه العلاّمةُ الإنجليزيّ "الدّوس هكسلي" من تخطئةِ من قالَ بضرورةِ كتابةِ العلمِ بلغةِ عامّةِ الإنجليزِ؛ لأنّ ذلك يُضعفُ المواهبَ العلميّةَ ويقضي على مَلَكَةِ الإنشاءِ بالفصحى، وترقيةُ عقولِ العامّةِ لفهمِ لغةِ العلمِ أفضلُ من نزولِ العُلَماءِ إلى العامّةِ، فيتراجعونَ ويتأخّرونَ. كما لا ننسى أنّ إفريقيا كانَ يُلاحقُها شبَحُ "الفرنكفونيّة" وذلكَ لمطاردةِ اللّهجاتِ المحلّيّةِ والقضاءِ عليها، فجيّشَ الاستعمارُ الفرنسيُّ جيش ذو ذا عدّةٍ ثقافيّةٍ واقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ وذو نظريّاتٍ علميّةٍ وآراء أكاديميّةٍ وعُلَماء يجتهدون في تَسويغِ سياستِه والدّفعِ بخُطَطِه وتثبيتِ وجودِه، ثمّ ما لبثَت هذه المُطاردةُ الفرنكفونيّةُ أن تطوّرت في صيغٍ مُخْتلفةٍ منها إحداثُ "اللّجنة العُلْيا للدّفاعِ عن اللّغةِ الفرنسيّةِ ونَشْرِها" سنةَ 1966 م، التي تحوّلت فيما بعدُ إلى "اللّجنة العليا للّغةِ الفرنسيّة"، ومنها إحداثُ "وكالة التّعاوُنِ الثّقافيّ والتِّقْنِيّ" سنة 1970 م ضمّت خمسًا وعشرينَ دولةً ناطقةً باللّغةِ الفرنسيّةِ جُزْئيًّا أوكلّيًّا، وما زالت فرنسا إلى اليومِ، تواصلُ عَمَلَها على إنعاشِ لغتِها وثقافتِها في الدّولِ الإفريقيّةِ، بل نشطت في ذلك خصوصًا بعد حركاتِ الاستقلالِ الصّوريّةِ التي عرفتها المُسْتَعْمراتُ الفرنسيّةُ القديمةُ([21])، وقد عملت هذه المنظَّماتُ الفرنسيّةُ على هزِّ الكيانِ اللّغويّ في إفريقيا الفرنكفونيّةِ وغَرْسِ بذورِ الثُّنائيّةِ اللّغويّةِ وتعهُّدِها ورِعايتِها، للحفاظِ على مصالحِ فرنسا الاستعماريّةِ في المنطقةِ، بل عمد الاستعمارُ - كما تذكرُ النّصوصُ([22]) - إلى إشهارِ السّلاحِ في وجهِ العربيّةِ، وذلكَ بإصدارِ قراراتٍ بحظرِ استعمالِ اللّغةِ العربيّةِ بالقوّةِ. ولعلّ الفصحى لم تجد من يُخاصِمُها في النّصفِ الأوّلِ من القرنِ العشرينَ حقَّ الخصامِ، مثل سلامة موسى القبطي الذي تَجنّد للدّعوةِ إلى نبذِها، ولويس عوض([23]) الصّليبيّ الذي أُقْحِمَ في الجامعةِ المصريّةِ وظلّ يدرِّسُ بها لا يعرِفه أحدٌ، وعبد الحميد يونُس، وأحمد لُطفي السّيّد الذي يُعتبرُ من حَمَلَةِ لِواءِ "تمصيرِ اللّغة الفصحى"، وأنيس فريحة صاحب كتاب "نحو عربيّةٍ ميسَّرَة" الدّاعي إلى اتّخاذِ العامّيّةِ وحاملِ آراءِ سلامة موسى، وكلّهم يزعمُ أن العربيّةَ قاصرةٌ عن نقلِ آثارِ الغربِ وعُلومِه؛ بدعوى أنها لغةٌ بدويّةٌ صحراويّةٌ، وأنهم يُعانونَ التّرجمةَ إلى اللّغةِ الفصحى([24])... والحقيقةُ أنّ "صُعوبةَ التّرجمةِ" قُصورٌ تتنزَّه عنه اللّغةُ العربيّة، وإنّما القصورُ في التّراجِمة أنفُسِهم؛ لجهلِهم بمعجمِ العربيّة الواسع، وقواعدِها وآدابِها ومفرداتِها ونوادِرِها وأمثالِها. والعيبُ كلُّ العيبِ في نسبةِ القصورِ إلى العربيّة، وهي اللّغةُ المرِنةُ التي وسِعَت علومَ يونان وفلسفتهم منذ قرون، وما زالت إلى يومِنا هذا تتّسعُ لآدابِ الغربِ وعُلومِه وفُنونِه، ولم تقصرْ عن ذلك ولم تعجز([25]). وكلُّ ما جاءَ به أنيس فريحة سبقَه إليه سلامة موسى، ولم يكن سلامة موسى مُبتكِرًا، ولكنّه أخذَ أفكارَ مجموعةٍ من المستشرِقينَ الذينَ كانَ يُحرِّكُهم العدوانُ الصّليبيّ، ومشاعِرُ هؤلاءِ المستشرِقينَ انتقلَت إلى ذلك الجيلِ من الدّارسين العربِ، وما زالَت تنتقل، والأصلُ واحدٌ والفروعُ متعدِّدةٌ. ولقد كان الهدفُ من وراءِ هذه الحملةِ وقْفَ العربيّةِ عن النّموِّ، وهي لغة الفكرِ والعلمِ والعِبادةِ لدى ملايينِ المسلمينَ، وإحداثَ لغةٍ وسطى بين العامّيةِ والفصحى، وذلكَ للنّزولِ بالثّقافةِ والفكرِ إلى مستوى العامّيّةِ. ويتّصلُ بهذا الهدفِ إقصاءُ القرآنِ الكريمِ عن اللّغةِ، وعزلُ البلادِ العربيّةِ، والفتُّ في عضدِها، وإبعادُها عن فهمِ كتابِها، وتعطيلُ أحكامِه. والغريبُ في هذه الدّعوةِ أنّها استطاعت أن تتسلَّلَ إلى مجمعِ اللّغةِ العربيّةِ، الذي كانَ يضمُّ أعضاءً هُم أعداءٌ للعربيّةِ الفصحى، من أمثال عيسى إسكندر المعلوف والمستشرق "جيب". لقد استطاعَ الاستعمارُ بكلِّ ما أوتيَ من قُوى أن يستحوذَ على البلدانِ المغلوبةِ على أمرِها، وأن يُنشئَ خطابًا لغويًّا استعمارِيًّا حولَ اللّغةِ والثّقافةِ يَقْدَحُ في ثقافةِ تلكَ البُلدانِ ويغضّ من شأنِها الحضاريِّ والتّاريخيّ، زاعمًا أنّ اللّغاتِ الأوربّيةَ هي اللّغاتُ الحقيقيّةُ التي تحملُ العلمَ والحضارةَ والثّقافةَ، ولا يُحْصَلُ على التّقدّم والرّقِيِّ إلاّ بها، ولا يولَجُ عالمُ الحداثةِ والمُعاصَرةِ إلاّ بوساطتِها، أمّا ما عداها فلا يعدو أن يكونَ لهجاتٍ أو لُغَيّاتٍ أولُغاتٍ قديمةً لا تقوى على حملِ الأفكارِ الحديثةِ والمفاهيمِ العلميّةِ الجديدةِ، ولم تلبثْ أهدافُ الخطابِ الاستعماريِّ العُنْصُرِيّةُ أن تغلغلت في نفوسِ كثيرٍ من أبناءِ هذه الأمّةِ، فباتوا يستمسكونَ بها ويُدافعونَ عنها ويتبنَّوْنَها([26]). ومن روّادِ هذا الخطابِ اللّغويّ الاستعماريّ العالِمُ اللّغويّ "شليجل" "Schlegel" صاحبُ نظريّةِ التّطوُّرِ والارْتِقاءِ في اللّغاتِ البشريّةِ، وقد قسّمَ اللّغاتِ إلى فصيلةٍ تحليليّةٍ وأخرى إلصاقيّةِ وثالثةٍ عازلةٍ([27])، وتُعدُّ اللّغات الهندية-الأوربّيّةُ - في نظرِه - في "قمّةِ هرمِ الارْتِقاءِ والتّطوّرِ"، ولُغات "السّودِ في أسفلِ السّلّمِ"، لأنّها لُغاتٌ "بدائيّةٌ"([28]) ويُمثّلُ "شليجل" - في تصوّرِه ونظريّاتِه- التّوافُقَ التّامَّ بينَ الخطابِ الإداريِّ الاستعماريّ والخِطابِ اللّسانيّ في بدايةِ القرنِ العشرينَ، حيث كانت الإدارةُ الاستعماريّةُ تستعينُ بالعلماءِ والباحثين والمفكّرينَ في تسويغ هيمنتها وبسطِ نفوذِها وترسيخِ عقيدتِها التي تزعم أنّ الشّعوبَ المُسْتَعْمَرَةَ حظيت بتعلّمِ لغةِ العالَمِ المتحضِّرِ، وأنّ لهجاتِها هي لا تقوى على حملِ ثقلِ الأفكارِ الحديثةِ والمفاهيمِ العلميّةِ، وليست أهلاً لأن تصبِحَ لغاتٍ صالحةً للتّعليم والبحثِ والثّقافة. ب- بين العربيّة الفُصحى و"الحداثة": تتّصلُ الحداثةُ بالتّغريبِ اتّصالاً وثيقًا ؛ لأنّها تجدُ في تغريبِ([29]) المجتمعاتِ العربيّةِ الإسلاميّةِ، أصلاً من أصولِها الفكريّةِ وجذرًا من جذورِها السيّاسيّة. وقد تَعامى كثيرٌ من المُثَقَّفين العَربِ "المُستغْرِبين" عن الاختلافِ بينَ ثَقافةِ العربِ وثَقافةِ الغربِ، والاخْتلافِ بين مقولاتٍ وُلدَت من رَحِمِ الحداثةِ الغربيّةِ ومقولاتٍ هي من صلبِ الحضارةِ الإسلاميّةِ، وخَلَطوا بين "التّحديثِ" و"الحَداثة"([30])، بل منهم من أشفقَ على الحداثةِ في بعضِ أقطارِ العالَم العربيّ، عندَما "لاحظَ" أنّها في سياقِ التّحوُّلاتِ الجاريةِ تواجهُ عوائقَ عدّةً، منها «ضعفُ المجتمعِ المدنيّ» و«الطّبيعة الاستبدادية للسّلطة» و«نقص المهارةِ التّقنيّة» و«الوقوف في وجهِ كلّ محاولةٍ لفصلِ الدّولةِ عن الدّين»([31]). ومنهم من توسّطَ فرأى أنّه لا توجدُ حداثةٌ مُطْلَقة كلّيةٌ عالميّةٌ، بل الحداثةُ "حداثاتٌ" مُخْتلِفةٌ باختلافِ الزمانِ والمكانِ والتّجربةِ، ومشروطةٌ بظروفِها، ولذلك ينبغي مُراعاةُ أثرِ "الخاصِّ" في الثّقافةِ العربيّةِ المعاصرةِ، وهوالأثرُ الذي يجعلُ من هذه الحداثةِ "حداثةً عربيّةً"([32]). وهناك موقفٌ ثالثٌ، من الحداثة، يتميَّزُ عن سابقَيْه بنقدِ الأُسُسِ التي قامت عليها الحداثَةُ الغربِيّةُ خُصوصًا، والحضارةُ الغرْبيّةُ على وجهِ العُمومِ، فهي حضارةٌ تقومُ على "العقلانيّةِ" وتفتقرُ إلى "الأخلاقيّة"([33])، وصارَ راسخًا في الأذهانِ بوساطةِ السّيلِ الجارِفِ من الأقوالِ الذي تحمِلُه هذه الحضارةُ الحديثةُ، أنّ الأخلاقَ لا تخدمُ إلاّ الضّعفَ في النّفسِ والخذلانَ في السّلوك، فينبغي إعادةُ صياغة هذه الحضارةِ بتسديدِها بالأسس الأخلاقيّة، حتّى تهتدِيَ إلى معرفةِ المقاصدِ النّافعةِ . وإذا كانت الحداثةُ "موقفًا مُغايرًا"، و"تمرُّدًا على الذّاتِ"، و"خُروجًا عن المُتَعارَف المألوف" واستجابةً تلقائيّةً لنُظمِ التّحديثِ السّائدة وحالةً أصابت الحياةَ العربيَّةَ المعاصرةَ في كلِّ جوانبِها، فغَيَّرت نمطَ العيشِ وطرُقَ التّفكيرِ، فإنّ اللّغةَ العربيّةَ لم تُستَثْنَ من هذا التّغييرِ الجارفِ؛ فهُجِرت ألفاظٌ واستُحدِثت أخرى، بقياسٍ وبغيرِ قياسٍ، بل هُجرت العربيَةُ الفصحى في ميدانِ العلومِ المعاصرةِ والثّقافةِ الحديثةِ الوافدةِ، وعُدّت الفَصاحةُ - التي هي من صفاتِ القُرآنِ والحديث- ضرْبًا من الافْتنانِ في القولِ لا صلةَ له بالواقعِ، وسُلطةً في وجهِ تحديثِ اللّغةِ، وعائقًا في طريقِ تطويرِها، ومظهَرًا من مظاهرِ الاستبدادِ بها([34])، ولم يكن للّغة بدٌّ من تحديثِها وذلك بإنشاءِ "فصاحةٍ جديدةٍ" تخرقُ قواعدَ "الفصاحةِ القديمةِ"، وذلك بإدراجِ لُغَةِ الصّحافةِ، وهوما دعاه الباحثون بـ"فصاحةِ الحدَثِ الصّحفي"، حيثُ أشادوا "بالأسلوبِ السّهلِ المُشرِق" الذي طَرَأَ على العربيّة اليومَ، ورَجَعوا "الفضلَ" فيه إلى الصّحافةِ دونَ غيرِها من وسائلِ نشرِ اللّغةِ وتعليمِها([35])، مُعَلّلين الحاجةَ إلى مثلِ هذا الأسلوبِ الجديدِ، بأنّ قواعدَ الفُصحى النّحويةَ والصّرفيةَ والمعجميّةَ قد رمّت عظامُها، وزالَ ظلُّها، وحالَ لونُها، وحانَ تحديثُها. وهكذا أصبحت العربيّةُ اليومَ تُعاني في ظلِّ الحداثةِ غربةً قاسيةً تُضافُ إلى ملفِّ غُرْبَتِها الثَّقيل. ويشهدُ تاريخُها القديمُ وواقِعُها من بين لُغاتِ العالَمِ اليومَ، أنّها قادِرَةٌ على تحقيقِ النّمووالاتّصالِ، والتّعبير عن المعلوماتِ الحديثةِ، ومواكبةِ التّطوّرِ الجديدِ في الميادينِ المختلفةِ، ويمكنُ أن يكونَ لها أثرٌ بارزٌ في "تحديثِ العقلِ العربيِّ" وتحقيقِ "التّنويرِ" الذي يرفعُهُ المُثَقَّفونَ "الحداثيّونَ" شعارًا من شعاراتِ المرحلةِ الجديدةِ، وباطلٌ ما يدّعونَ من أنّ هذه اللّغةَ لا قدرَةَ لَها على الإسهامِ في "الحركةِ الدّلاليّةِ والتّعبيريّةِ الحديثةِ". ج- بينَ العربيّةِ الفصحى والعامّيّة: هل تمتلكُ العامّياتُ والدّوارِجُ قواعدَ أو نظامًا كما تمتلِكُه العربيّةُ الفصحى؟ الجوابُ أنّها لا تمتلكُ القواعدَ النّظاميّةَ التي تنظّمُ الأبنيةَ والأصواتَ والتّراكيبَ والمعاني؛ فهي قد اختصرت القواعدَ واختزلتها، واستغنت ببعضِ الصّيغِ عن بعضٍ توخّيًا للسّهولةِ التي تتّفقُ والعامّياتِ وتُناسبُها، ومن الأمثلةِ على ذلكَ أنّ قاعدةَ المبنيّ للمجهولِ لا وجودَ لها في الدّوارِجِ والعامّيّاتِ؛ فقد قنعت هذه اللُّغَيّاتُ ببدلٍ من ذلك يتجلّى في فعلِ المطاوعةِ، فلا تستعمِلُ الفعلَ "ضُرِبَ" مثلاً ولكنّها تقولُ "انْضرب" أو"اتضرب"، ولا يعدُّ هذا الاستبدالُ ميلاً إلى قواعدَ جديدةٍ ولكنَّه يتعلّقُ بالتّخلّي عن قوانينِ العربيّةِ في الإعرابِ والصّرفِ، وقد حملَها هذا التّخلّي، على اتّخاذِ المبتدإِ بدلاً من الفاعلِ المُظهَرِ لئلاّ يقع اشتباه بين كلماتِ الجملةِ؛ فهي لا تستطيعُ أن تقول "ضربْ محمّدْ زيدْ" لأنّها لا تستعملُ حركاتِ الإعرابِ التي هي في الأصلِ واقعةٌ على أواخرِ الكلِمِ ومائزةٌ بين المعاني، وقد تخلّصت من هذا الاشتباهِ بتقديمِ الفاعلِ على الفعلِ فأصبح مبتدأً، وذلك نحو "محمّدْ ضربْ زيدْ"، وليسَ المبتدأُ إلاّ بابًا في العربيّةِ، أمّا في العامّيّةِ الدّارجةِ فهو البابُ الوحيدُ تقريبًا، وقد حَمَلَ العامّيّةَ على الاكتفاءِ بالجملةِ الاسميةِ التي خبرُها فعل، عن الجملةِ الفعليّةِ فقدانُ الإعرابِ([36])، فهي لهجةٌ أولُغَيَّةٌ عفويّةٌ عشْواءُ، تقْتاتُ على مائدةِ الفصحى ولُغاتِ المستعمِرينَ المترسِّبَةِ في بُلدانِنا([37])، وتفتقِرُ إلى كلِّ شروطِ الدّقّةِ والإحكامِ، ولا يصحُّ في المنطقِ وطبائعِ الأشياءِ أن تكونَ العامّيّةُ أوّلَ ما يتلقّاه الطّفلُ؛ لأنّه إذا لُقِّنَها ابتداءً فسيتكوَّنُ له سَنَدٌ هشٌّ ينظرُ به إلى العالَمِ وبه يُفكِّرُ ويُعبِّرُ، فيكون ضحلَ الفكرِ ضعيفَ التّصوُّرِ قاصرَ النَّظرِ، لا يُنتجُ علمًا ولا معرِفةً، ولا قدرةَ له على التّنظيرِ والتّخطيطِ لأنّه لن يرى من الأشياءِ إلاّ ما تُريه إيّاه اللّهجاتُ والدّوارِجُ، ولن يُدرِكَ العالَمَ إلاّ على الهيئةِ المضطرِبةِ المفكَّكةِ التي تتبادرُ إلى ذهنِ هذه الدّوارجِ، وهو بعد ذلكَ إذا تعلّمَ لغةً ذاتَ نظامٍ وقواعدَ مُطَّرِدةٍ، فيما بعدُ، فسيُنزِّلُها في نفْسِه وفكرِه على ذلك السّندِ الهشِّ، الذي هوالعامّيّة والدّوارجُ واللّهجاتُ المحلّيّةُ، أي إنّ هذه الأخيرَةَ ستكونُ له أرضًا وسندًا، تستقرُّ عليها الفصحى ويستقرُّ عليها كلُّ ما تحملُه الفصحى من قيمٍ فكرِيّةٍ واجتماعيّةٍ وعقَديّةٍ... وستكونُ النّتيجةُ معروفةً وهي أن تكونَ الدّوارِجُ والعامّيّاتُ مَعْبَرًا وجسرًا إلى العربيّةِ الفصحى، وسيتأثّرُ بها في تعلُّمِ الفصحى، ولن تستقيمَ له أيّةُ لغةٍ تعلَّمَها فيما بَعدُ، على خلافِ ما إذا تلقّى اللّغةَ العربيّةَ الفصيحةَ ابْتِداءً ؛ لأنّها ستُنْشِئُ له رصيدًا من القواعدِ الصّحيحةِ المبنيةِ بناءً مُحكَمًا، ونمطًا رفيعَ المستوى. وقد أخبرَ اللّغويُّ الغرْبيُّ "آدم كزيفسكي"([38]) أن كثيرًا من الأخطاءِ التي يرتكبُها التّلميذُ في بداياتِ تعلُّمِه لِلُغةٍ ثانيةٍ راجعةٌ إلى ميلِه إلى قياسِ تراكيبِ اللّغةِ الثّانيةِ على تراكيبِ اللّغةِ الأمِّ، وفي ذلك تحكيمٌ لبنياتِ اللّغةِ الأولى في تركيبِ اللّغةِ الثّانيةِ وبنائِها ووقوعٌ في كثيرٍ من الأخطاءِ في إنجازِ جُملِ الثّانيةِ، وتفسيرُ ذلكَ أنّ التّلميذَ يلجأُ إلى لغتِه الأمّ ليستمدَّ منها كلَّما عجزَ عن التّعبيرِ باللّغةِ الثّانيةِ، فيحصلُ التّداخلُ والخلطُ. وهذا أمرٌ مقرَّرٌ في اللّسانيّاتِ، فمن المعروفِ أنّ الطّفلَ يتعلّمُ لغتَه الأمّ بإتقانٍ ويكتسِبُها بسهولةٍ وسرعةٍ لأنّه مزوّدٌ بآلياتٍ نفسيّةٍ مركوزةٍ في طبعه، تمكّنُه من سرعةِ الاكتسابِ، ولكنّه لا يفعلُ ذلكَ إلاّ بتوجيهِ الآباءِ والمدرِّسينَ وعُمومِ البيئةِ التّربويّةِ والاجتماعيّةِ التي توطّنُ الطّفلَ على تركيبِ الجملِ الصّحيحةِ وتجنّبِ اللّحنِ في الكلامِ، وتعملُ على انطلاقِ عمليّةِ نمو اللّغةِ في نفسِه انطلاقًا صحيحًا، وذلكَ بوضعِ المناهجِ المناسِبةِ، واخْتِصارِ الطّرُقِ المُفْضيةِ إلى سرعةِ التّعلُّمِ الصّحيحِ([39])، والغريبُ أنّ الطّفلَ أصبحَ عُرضةً للتّجاربِ التّربويّةِ التي تحرِصُ على شحنِه بأكبرِ قدرٍ ممكنٍ من الموادِّ الدّراسيّةِ في بدايةِ تلقّيه للمعرِفةِ. وأعودُ فأقولُ إنّ وجودَ العامّياتِ والدّوارِجِ أمرٌ طبيعيٌّ، ولا يوجدُ صراعٌ بين العربيّة الأمّ ولهجاتِها المتعدّدة ؛ لأن تعدّد اللّهجات في ظلّ لغةٍ أمّ ظاهرةٌ طبيعيّة مألوفةٌ في واقع الحياةِ وطبائعِ الأشياءِ، ولكنَّ الخَلَلَ في تحويلِ اللّهجاتِ العامّية إلى سلاحٍ ضدَّ العربيّة الفصحى، وهو ما اصطنَعَه الاستعمارُ، عندما استغلَّ اختلافَ اللّهجاتِ الإقليميّةِ ليجدَ ذريعةً للقضاءِ على اللّغة المشتركة التي تصلُ بين أجزاءِ الأمّة وتشدّ بعضَها ببعضٍ في منهجِ التّعلُّمِ هو أن تكونَ الدّوارِجُ أوّلَ ما يتلقّاه الطّفلُ، وأوّلَ ما يفتحُ عليهِ عينيهِ فيبني منه مقاييسَه اللّغويّةَ الأولى. ويترتّبُ على ذلكَ ترسُّخ هذه المقاييسِ الهشّةِ المُتَهافِتةِ وترسُّبُها في ملَكةِ الطّفلِ اللّغويّةِ، وتأثيرُها في تعلُّمِ اللّغةِ الفصيحةِ. والحصيلةُ أن تُصابَ هذه الفصيحةُ بالرّكاكةِ والضّعفِ في التّركيبِ والأبنيةِ والمعجمِ والدّلالةِ، وباللّحنِ والإحالةِ في النّطقِ وتعثُّرِ اللّسانِ في التّلفُّظِ ؛ وما ذلكَ إلاّ لأنّ الطّفلَ يصدُرُ في الكلامِ عن مخزونٍ لغويٍّ مشوَّهٍ، لا يستقيمُ له نَسقٌ في التّركيبِ ولا بيانٌ في العبارةِ ولا وُضوحٌ في الدّلالةِ والمقاصدِ ؛ لأنّه كلّما هَمّ بالأداءِ اللّغويِّ الفصيحِ اعترَضت طريقَه اللّكنةُ العامّيّةُ والعُجمةُ واللّهجاتُ المحلّيّةُ، أو إن شئتَ فقُل إنّه كلّما همَّ بالكلامِ العربيّ الفصيحِ قَفَزَ إلى لِسانِه خليطٌ من الفصحى واللّهجاتِ المحلّيّةِ فيتكلّمُ ببعضِ العباراتِ الفصيحةِ التي هي عبارةٌ عن جُزُرٍ مُتَباعدةٍ في نفسِه، يتخلّلُها كُلُّ ما ليسَ بفصيحٍ، ويملأ الفراغاتِ التّعبيرِيّةَ والقوالبَ اللّغويّةَ الفارغةَ بالكثرةِ الكاثرةِ من الألفاظِ العامّيّةِ التي أُغْرِقَ في خضمِّها وهو ينمو ويتلقّى لغتَه. وهناك عيبٌ منهجيٌّ آخر وهوانتشارُ الدّعوةِ إلى اتّخاذِ اللّهجاتِ الدّارِجةِ والعامّياتِ في الوطنِ العربيِّ بدلاً من العربيّةِ الفصحى، وذلك قياسًا على الأوربّيّين الذين يتّخذونَ اللّغةَ المنطوقةَ بدلاً من اللّغةِ التّقليديّةِ المكتوبةِ، وتقليدًا لهم. والدُّعاةُ إلى هذا التّقليدِ يقولونَ: يجبُ أن تكونَ لدينا لغةٌ منطوقةٌ محكيّةٌ بدلاً من المكتوبةِ الفصيحةِ، كما لغيرِنا في ديارِ الغربِ، وما أشبَه هؤلاءِ بقومِ موسى إذ قالوا لنبيِّهم: ]اجْعَلْ لَنَا إلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ[([40])، ويقولون إنّ العربيّةَ الفصحى أصيبت بشيءٍ من العُقمِ([41])، بعدَ أن انقطعت الصّلةُ بينها وبين الشّعوبِ العربيّةِ، في حين أنّ العامّيةَ بقيت تُولَّد. لذلك يليقُ بالفصحى - في نظرِهم – أن تتبنّى بعضَ مُوَلَّداتِ العامّيةِ، كالأفعالِ الرّباعيةِ، على وزنِ "فعلل"، التي يكثرُ استعمالُها في العامّياتِ والدّوارِجِ العربيّةِ، ولا فرقَ عندَهم أكان في الفصحى ما يُقابلُ مثلَ هذه الأفعالِ وغيرِها أم لم يكن، فضمُّها إلى الفصحى، وضمُّ أسماءٍ ومصطلَحاتٍ كثيرةٍ ابتدَعتْها العامّيةُ من شأنِه أن يزيدَ في ثروةِ اللّغةِ لا أن يقلِّلَ منها. والحقيقةُ أنّ القولَ بأن العربيّةَ الفصحى أصيبت بالعُقمِ وحانَ أوانُ انْقِراضِها، بعيدٌ عن الصّوابِ؛ لأنّها تمتلكُ آلياتِ توليدِ الألفاظِ والمصطلحاتِ ولا تضيقُ بالجديدِ، وتتضمّنُ أدواتِ الاشتقاقِ والنّحتِ والاقتراضِ والتّعريبِ، فليس العيبُ فيها ولا القُصور، وإنّما العيبُ في إهمالِ هذه الآلياتِ وعدمِ تشغيلِها لتولِيدِ الجديدِ، ولا يصحُّ أن تتبنّى العربيّةُ بعضَ مولَّداتِ العامّيّاتِ وتضمَّها إليها ؛ لأنّ في آلياتِ العربيّةِ الصّرفيةِ والصّوتيّةِ ما يُغنيها عن اللّجوءِ إلى العامّيةِ، ويُزوِّدُها بما تحتاجُ إليه في ميدانِ التّوليدِ الدّلالي، وإذا تصوّرْنا أنّ العربيّةَ تلجأُ إلى العامّيّةِ وتستجدي منها الألفاظَ وتستمدّ منها الدّلالة، فإنّ هذا اللّجوءَ سيتمادى مع الزّمنِ، وستتكاثرُ الموادّ اللّغويّة العامّيةُ على حساب المفرداتِ العربيّةِ التي تمتلئُ بها بطون المعاجمِ منتظِرةً من يحرِّرُها من أسْرِها، وفي ذلك إحياءٌ للعامياتِ وإمدادها بكلِّ شروطِ البقاءِ والانتعاشِ، وإماتةٌ للعربيّةِ الفُصحى وسلبُ كلِّ مقوِّماتِ الحياةِ منها، واتّخاذُ هذه بدلاً من تلك. إنّ اللهجاتِ المحلّيةَ والعامّياتِ لا يمكنُ اتّخاذُها بدلاً من العربيّةِ الفصيحةِ بحالٍ من الأحوالِ؛ وذلكَ لأن الفصيحةَ - في أصلِها - قد نزلَ بها القرآنُ الكريمُ، ووَصَلَها بالعقلِ والشّعورِ النّفسيِّ حتّى عمّت وانتشرت، فلو تخلّى عنها أهلُها واستبدلوا غيرَها بها «لحفظَها الشّعورُ النّفسيُّ وحدَه، وهو مادّةُ العقلِ بل مادّةُ الحياةِ [...] ولولا هذا الشّعورُ [...] لدُوِّنت العامّيّةُ في أقطارِ العربيّةِ زمنًا بعدَ زمنٍ، ولخرجت بِها الكتبُ، ولكان من جَهَلَةِ المُلوكِ وأشباهِهم - ممّن تتابعوا في التّاريخِ العربيّ - من يضطلِعُ من ذلكَ بعملٍ، إن لم يكن مَفْسَدَةً فمَصْلَحةٌ يزعُمها، كالذي فَعَلَه بعضُ ملوكِ الرّومانِ وبعضُ شُعَرائهِم في تدوينِ العامّيّةِ من اللاّتينيّةِ، حتّى خرجَ منها اللّسانُ الطّليانيُّ، وكما فعلَ اليونانُ في اسْتِخْراجِ اللّسانِ الرّوميّ، وهوالعامّيّ من اليونانيّةِ»([42])، أمّا العربيّةُ الفصحى فالذي أمسكَه القُرآنُ الكريمُ منها «لم يتهيّأْ في لغةٍ من لُغاتِ الأرضِ، ولم تتلاحقْ أسبابُه في لغةٍ بعدَ العربيّةِ، وهذهِ اللّغةُ الجرمانيّةُ انشقّت عنها فروعٌ كثيرةٌ في زمنِ جاهليّتِها، واستمرّت ذاهبةً كلَّ مذهبٍ، وهي تُثمِر في كلِّ أرضٍ بلونٍ من المنطقِ وجنسٍ من الكلِمِ، حتّى القرنِ السّادسِ عشَرَ للميلادِ؛ إذ تعلَّقَ الدّينُ والسّياسةُ معًا بفرعٍ واحدٍ من الفروعِ، هوالذي نُقِلت إليه التّوراةُ فاهتزّ ورَبا وأورقَ من الكتبِ وأزهرَ من العقولِ وأثمرَ من القلوبِ، وبعدَ أن صارَ لغةَ الدّينِ صار دين التّوحيدِ في تلك اللّغاتِ المتشابهةِ، وبقيت هي معه إلى زيغٍ حتّى انطوت في ظلّه، ثمّ ضحى بنورِه فإذا هي في مستقرِّها من الماضي ونسيَت نسيانَ الميّت... واللاّتينيّةُ، فقد استفاضت في أوربّا حتّى خرجت منها الفرنسيّةُ والطّليانيّةُ والإسبانيّةُ وغيرُها، وكان منها علميٌّ وعامّيّ بلغةِ العلمِ ولغةِ اللّسانِ، ثمّ أنت ترى اليومَ بين تلك اللّغاتِ جميعِها وبين ما تَخلَّف منها في مناطقِ هذا الجيلِ، ما لا تعرِفُ له شبيهًا في المتباعداتِ المعنويّةِ، حتّى كأنّ بينَ اللّغةِ واللّغةِ العَدَمَ والوجودَ »([43]). وهناك شبهةٌ أخرى مُتّصلةٌ بالتي سبقت، وهي الدّعوةُ إلى تيسيرِ العربيةِ وتبسيطِها وتَسْهيلِها، واختيارِ لغةٍ وسطى وإلغاءِ الإعرابِ، والدّافعُ إلى هذه الدّعوةِ هو ادِّعاءُ وجودِ صعوبةٍ في تعلُّمِ العربيّةِ الفصيحةِ. وعندي أنّ ادِّعاءَ الصّعوبةِ افتِراءٌ على الفصحى؛ لأنّ اللّغاتِ الأجنبيّةَ نفسَها لا تقلُّ عن العربيّةِ صعوبةً في التّعلُّمِ، والموادُّ المُلَقَّنَةُ للتّلميذِ كالرّياضيّاتِ وغيرِها أشدُّ صعوبةً ومع ذلك يكثُرُ مُجيدوها. وإنّ الزّعمَ بوجودِ صعوبةٍ في تعلُّمِ الفصحى افتِراءٌ لا مُسَوِّغَ لَه ؛ لأنّه ليسَ المرادُ عندَ دعاةِ تيسيرِ العربيّةِ وتبسيطِها البحثَ عن منزلةٍ وسطى مُيسّرةٍ، ولكنّ المرادَ عندَهم إقصاءُ الفصحى وزَحزَحتُها عن مكانِها، ليخلُوالمكانُ للعامّيّةِ والأعجميّةِ. وقد ردَّ الأستاذ عبّاس محمود العقّاد رحمه الله على هذا الافتِراءِ بقولِه: «وعندنا - وعندَ أنصارِ الفُصحى أجمعين- أنّ مسألةَ القواعدِ قد فُرِغَ منها في عصرِنا، فلا يجوزُ لنا أن نُلْغِيَها ولا أن نستحدِثَ بديلاً يُناقضُها، وكلّ ما يجوزُ لنا أن نتوسّعَ في تطبيقِها، وأن نقيسَ عليها ما يُماثلُها، وأن نحرِصَ على بقاءِ نحوِها وصرْفِها؛ لأنّ لغتَنا خاصّةً لا تبقى بغيرِ الإعرابِ، ولا تصحُّ المشابهةُ بينَها وبين اللّغاتِ التي لا إعرابَ فيها ولا اشتِقاق، لأن قوامَ اللّغاتِ القائمةِ على النّحتِ ولصقِ المفرَداتِ، غيرُ قوامِ اللّغةِ التي تختلِف بالحركةِ في كلِّ موقعٍ من مواقعِ الحروفِ، ولا سيما الحروف التي يقعُ عليها الإعرابُ»([44]). ولا شكّ أنّ الدّوارِجَ والعامّيّاتِ واللّهجاتِ، قد وَجَدت في البحوثِ الجامعيّةِ دَعْمًا وسنَدًا؛ حيثُ أُنجِزت كثيرٌ من الرّسائلِ والأطروحاتِ في ظواهرَ لغويّةٍ تطبيقيّةٍ على هذه اللّهجةِ أو تلك، بمنهجٍ لسانيٍّ واحدٍ أو بمناهجَ متقاربةٍ، على غرارِ ما هو سائدٌ في الجامعاتِ الغربيّةِ، تارِكينَ الفُصحى في معزلٍ عن الدّراسةِ إلاّ في القليلِ النّادرِ. وتمتدّ بذورُ الدّعوةِ هذه إلى القرنِ التّاسعِ عشرَ، حينَ نشرَ المستشرِقُ الألمانيّ "ولهلم سبيتا" سنة 1880 م - وقد كان مديرًا لدارِ الكتبِ المصريّةِ آنذاكَ - كتابًا باللّغةِ الألمانيّةِ في (قواعدِ اللّغةِ العامّيّةِ بمصرَ) دافعَ فيه عن ضرورةِ قيام اللّهجة العامّيّة بمهامّ التّعبير عن الحياة المعاصرة بمرافِقها المختلِفة؛ إذ إنّ الْتِزامَ الكتابة العربية الفصحى يحولُ دون نموالأدب وتطوّرِه، وانضمَّ إلى معسكرِه في الحربِ على الفصحى مستشرقون آخرونَ مثل "كارلولندبرج" و"كارل فولرس"، و"ولكوكس" فيما بعد. وقد تنبّأ "ولهلم سبيتا" بمصيرِ الفصحى إلى الموتِ! كما ماتت اللاّتينيّة، فلا بدّ من إحياءِ الدّوارجِ والعامّيّات ووَأْدِ الفصحى، وقد قارنَ هذا الوضعَ بما كانَ من أمرِ اللاّتينيّةِ التي أماتتْها اللّغاتُ الفرعيّةُ التي كانت في أوّلِ أمرِها لهجاتٍ محلّيةً أوتشبه اللّهجاتِ المحلّيّةَ، وقد قالَ "سبيتا" في مقدّمة كتابِه: «إنّ الصّراعَ بين العامّيةِ والفصحى مسألةُ حياةٍ أو موتٍ...». ولا ينبغي أن ننسى نوايا هؤلاءِ المستشرقينَ وروّادِ الاستعمارِ، التي كانت تُبيِّتُ لإسقاطِ العربيّةِ والتّمكين للعامّياتِ والأجنبيّة، كما لا ننسى الصّعوبةَ التي يجدُها هؤلاءِ في تعلّمِهم العربيّةِ الفصحى من أجلِ اكتشافِ فكرِها وحضارتِها، فكانَ أن واجهوا هذه الصّعوبةَ بالدّعوةِ إلى التّخلّي عن الفصحى وتجاوزها، إلاّ القليل منهم([45]). والنّماذج في هذا البابِ كثيرة، والمتأخّرونَ منهم وصلوا إلى وضعِ الفرضيّاتِ اللّسانيّة بخصوصِ وجودِ الشّبه بين العربيّةِ واللاّتينيّةِ من جهة، وبين الدّوارجِ العربيّةِ واللّغاتِ الحيّةِ الأوربّيةِ من جهةٍ ثانيةٍ. ومن هذه النّماذجِ المتأخِّرةِ العالِم اللّغويّ الفرنسيّ ميي "A.Meillet" في كتابه "اللّسانيّات التّاريخيّة واللّسانيّات العامّة"([46])؛ فقد تحدّثَ عن التّطوّرِ اللّغويّ، وبنى رأيَه على فرضيّةٍ مفادها أنّ السّماتِ العامّةَ للتّطوّرينِ تتماثلُ في كلِّ الحضاراتِ، وبناءً على هذه الفرضيّةِ عقدَ موازنةً بين تطوّرِ اللاّتينيّةِ وتطوّرِ العربيّةِ، وزعمَ أنّ التّطوّريْنِ متماثلانِ، واستنتجَ أنّ كلَّ واحدةٍ من هاتينِ اللّغتينِ قد أدّت إلى ميلادِ لغاتٍ متعدّدةٍ منفصِلٍ بعضُها عن بعضٍ؛ يقولُ: «تُعتبَر بعضُ اللّغاتِ بديلةً لِلُغةٍ واحدةٍ وُجِدت سابقًا؛ تعتبرُ الفرنسيّةُ والإيطاليّةُ مثلاً بديلينِ للاّتينيّةِ، وتعتبرُ العربيّةُ السّوريّةُ والعربيّةُ المصريّةُ والعربيّةُ المغربيّةُ - وهي تختلفُ فيما بينها عند الكلام - بدائلَ من لغاتِ الفاتحينَ العرب». وقد تحدّث علَماء لسانيّون آخَرون عن وجوهِ الشّبهِ بين حضارتيْنِ، فزعَموا أنّه لكي تتماثَلَ السّماتُ العامّةُ للتّطوّرِ في حضارةٍ من الحضاراتِ مع سماتِ تطوّرِ حضارةٍ أخرى، يجبُ أن تمرَّ الحضارتانِ بظروفٍ متقارِبةٍ إن لم نقلْ بالظّروفِ عينِها. وأنت ترى أنّ هذه الفرضياتِ عبارةٌ عن مزاعمَ نظريّةٍ؛ لأنّ الواقعَ يشهدُ بخصوصيّةِ الحضاراتِ وخصوصيّةِ اللّغاتِ، وليست اللّغاتُ كلُّها خاضعةً لمعاييرِ التّطوّرِ ذاتِها، فلكلِّ حضارةٍ خصوصيّتُها وطريقةُ تطوّرِها، وكذلك اللّغةُ، وهذِه الخصوصيّةُ تابعةٌ لظروفِ الأفرادِ الحضاريّةِ. وردَّ أَحَدُ الباحثينَ على تلك المزاعمِ النّظرِيّةِ التي لا أساسَ لها من الواقعيّةِ، بإثارةِ سؤالٍ وجيهٍ هو: كيفَ يمكنُ تفسيرُ تباعُدِ اللّغاتِ الأوربيّةِ (كالفرنسيّةِ والإيطاليّةِ وغيرهِما...) فيما بينَها، وتَقارُبِ اللّهَجاتِ العربيّةِ فيما بينها؟ ويُجيبُ بأنَّ تفسيرَ هذا الاختِلافِ بين المجموعتينِ في علاقتِهما بلُغَتِهما الأمِّ، لا يجوزُ أن يتمَّ برصدِ مفهومِ التّطوّرِ، بل بمفهومٍ آخَر هو مفهومُ القطيعةِ (Rupture)([47])؛ فالقطيعةُ مَسافةٌ لغويّةٌ تفصلُ بين لغةٍ مُحْدَثَةٍ وبين أصلِها التّاريخيِّ الذي انسلخت منه، وهي تتجسّدُ في شكلِ انقسامٍ كلّيٍّ حادٍّ بين اللّغةِ الأمِّ واللّغاتِ المتولّدَةِ منها، وهنا يمكن أن نتحدّثَ عن القطيعةِ في علاقةِ العربيّةِ والعِبريّةِ والأكاديّةِ والآراميّةِ والحبشيّةِ باللّغةِ الأمّ، أمّا التّطوّرُ فهو أمرٌ يصيبُ اللّغةَ نفْسَها في بنيتِها ومعجمِها وأصواتِها، وذلك في ضوءِ تطوّرِ المجتمعِ والمفاهيمِ والعقائدِ، على نحو ما قالَ ابنُ فارِس اللّغويّ: «فلمّا جاء الله تعالى جلّ ثناؤه بالإسلامِ حالت أحوالٌ، وانْسَلَخَت دياناتٌ، وأُبطِلت أمورٌ، ونُقلت من اللّغةِ ألفاظٌ عن مَواضِعَ أُخَرَ بِزياداتٍ زيدت وشرائعَ شُرعت وشَرائطَ شُرِطت، فَعفى الآخِرُ الأوّلَ»([48]). أمّا اللّهجاتُ، فلكي تُعَدَّ حالةً من حالاتِ التّطوّرِ، يجبُ أن يكونَ لألفاظِها البنى نفسُها التي تقومُ عليها ألفاظُ اللّغةِ، ولتراكيبِها تراكيبُ اللّغةِ نفسِها، عمومًا؛ ففي الأصواتِ تمثِّلُ اللّهجاتُ تطوّرًا صوتيًّا للغةٍ واحدةٍ؛ فقد تحدّ ثَ اللّغويّون منذ القديمِ عن عنعنةِ تميمٍ، وكشكشةِ ربيعَةَ، وكسكسةِ هَوازِنَ، وعجرفِيّةِ ضبّةَ، وقَطْعةِ طيِّئ، وعَجْعجةِ قُضاعةَ وغَمْغَمتِها، وتلْتلةِ بَهْراءَ، وطُمطُمانيّةِ حِمْيَر، واسْتِنْطاءِ أهلِ اليمنِ ووتْمِهِم وشنشنتِهم، ولَخْلَخانِيّةِ أهلِ العراقِ، وتضجُّعِ قيسٍ، وفشفشةِ تغلبَ، وفَحْفَحةِ هذيلٍ([49])... فهذا التّنوُّعُ مظهرٌ من مظاهرِ التطوّرِ الصوتيّ في جسمِ اللّغةِ الواحدةِ. وهذا التّفرُّدُ الصّوتيّ الذي نجدُه في كلِّ لهجةٍ يعني أنّ اللّغةَ الأمّ تمتلكُ القدرةَ على أن تكونَ منطوقةً بعدّةِ طرُقٍ صوتيّةٍ تُمثِّلُها اللّهجاتُ، وهذا معروفٌ في اللّغةِ الإنجليزيّةِ بين فرنسا وإنجلترّا، وفي الفرنسيّةِ بين فرنسا وبلجيكا وكندا... ومجموعُ هذه الخلافاتِ الصّوتيّةِ لا تجعلُ من اللّهجاتِ لغاتٍ مستقلّةً بذاتِها. بل يمكنُ تفسيرُ الخلافِ بين الفصيحةِ والعامّيّةِ بأنّ الأمرَ يتعلّقُ بإنجازاتٍ متعدِّدةٍ لقدرةٍ لغويّةٍ واحدةٍ؛ فالمستمِعُ العربيُّ يستطيعُ عبرَ قدرتِه اللّغويّةِ الفطريّةِ أن يفهَمَ ما يسمعُه من جملٍ فصيحةٍ وإن لم يُنجِزْ جملَه بالعربيّةِ الفصيحةِ. فليسَ معنى الخلافِ بين الفصيحةِ والعامّيّةِ وجودَ ازدواجيّةٍ بينَ هذه الإنجازاتِ؛ لأنّ الازدِواجيّةَ تعني وجودَ صِراعٍ بينها([50])، وهذا أمرٌ مُنْتَفٍ عنها، وهو من شأنِ اللّغاتِ "الحيّة" في أوربّا. وهنا يُلاحَظُ أنّ التّواصُلَ والتّفاهُمَ أمرٌ قائمٌ بين المتكلِّمينَ العرَب من مناطِقَ مختلِفَةٍ، على تنائي الدّيارِ واخْتلافِ الأقطار؛ فالخِلافُ بينَ الفصيحةِ والعامّيّةِ خلافٌ في الإنجازِ والسّليقةُ واحدةٌ، ومرجعُ الخلافِ إلى ثقافةِ كلِّ متكلِّمٍ ومستَواه وطريقَةِ بيئتِه في النّطقِ بالحروفِ... كما هو الشّأنُ في سائرِ اللّغاتِ، فالخِلافُ بين هذه العامّيّاتِ العربيّةِ خلافُ تنوُّعٍ لا خِلافُ تضادٍّ، ولا يرقى إلى مرتبةِ إماتةِ اللّغةِ الأمِّ أوالجَوْرِ عليها، أمّا الخلافُ بينَ اللّغاتِ المتفرِّعةِ عن اللاّتينيّةِ فهوخلافُ تضادٍّ، أدّى إلى إماتةِ اللّغةِ الأمّ. وخِلافُ التّنوُّعِ الذي تتَّصِفُ به الدّوارِجُ العربيّةُ، كما أسلفْنا ذِكْرَه، مظهرٌ من مظاهرِ التّطوّرِ الذي تمرُّ به العربيّةُ اليومَ، وهوتطوّرٌ فريدٌ من نوعِه في تاريخِ تطوّرِ اللّغاتِ؛ ذلكَ أنّ اللّغاتِ تتطوّرُ في خطٍّ يقودُها إلى التّباعُدِ والقطيعةِ مع الأمّ، لكنّ العربيّةَ، كما يُلاحظُ، تعيشُ تطوّرًا عكسيًّا يعودُ بِها من شكلِها العامّي الدّارِجِ المُتَعَدِّدِ إلى شكلِها الفصيحِ المُوحّدِ الذي كانت عليه، والسّببُ في ذلك هو التّواصلُ المستمرُّ بين النّاطقينَ بالعامّياتِ العربيّةِ ومصادرِ الدّينِ العربيّةِ التي حفظت الفُصحى ورَعَتْها، فظلّت العامّيّاتُ مُخلِصةً للعربيّةِ ولحضارتِها لا عاقَّة لها، على خِلافِ اللّغاتِ "الحيّة" التي انفصمت عن الأمِّ لانفِصالِ المدنيّةِ الأوربّيّةِ عن الدّينِ، واضطِرارِها إلى لغةٍ موحّدةٍ تتواصلُ بها، فلم تجد هذه المدنيّةُ المادّيّةُ إلاّ اللّغةَ الإنجليزيّةَ للتّواصلِ، ومعلومٌ أنّ الإنجليزيّةَ لا تمثّلُ اللّغةَ الأصليّةَ لأوربّا كلّها. يتبيّنُ ممّا سبقَ أن عَرَضَه الباحثُ([51]) أنّ حركةَ الاستعمارِ والاستشراقِ اتّخَذت أدواتٍ لفكِّ المركّبِ الحضاريِّ الإسلاميّ وتغييرِه بمركّبٍ حضاريٍّ غربيٍّ هوالحضارةُ اللاّتينيّةُ المسيحيّةُ، ولكنّها لم تُفلِح في تغييرِ لغةِ التّعبيرِ العربيّةِ ولم تُفلح في التّمكينِ للعامّيّاتِ؛ لأنّ القرآنَ الكريمَ يشدّ أزرَ لغةِ التّعبيرِ ويحفظُها، ويرعى السّلائقَ اللّغويّةَ العربيّةَ المتفاوتَةَ([52])، ولأنّ مشروعَ التّغريبِ قاطعٌ للأواصرِ مع الإسلامِ والعروبةِ، وغيرُ قادِرٍ على إثباتِ دعوى اعتِبارِ الغرْبِ محورَ العالَم والحضارةِ، واعتبارِ الإسلامِ والعُروبةِ عنوانًا على التّخبُّطِ والجُمودِ. وقد انجرفَ مع هذه الدّعوى الموهومةِ جَحافلُ من السّاسةِ والمثقّفينَ العربِ، من دونِ جدوى وبلا فائدةٍ تُرْجى. لكنّ الحقيقةَ أنّ قياسَ الدّوارِجِ العربيّةِ على اللّغاتِ الحيّةِ الأوربّيّةِ لم يكنْ يُرادُ منه إلاّ تقسيم العالَمِ الإسلاميِّ بحسبِ لهجاتِه؛ بيدَ أنّه عالَمٌ واحدٌ وأمّةٌ واحدةٌ، لها من مقوِّماتِ التّوحيدِ أكثرُ ممّا لغيرِها من الأممِ، ومصيرُ اللّهجاتِ العربيّةِ إلى التّوحُّدِ لا التّباعُد ، وهو ما تُثبِته الوقائعُ باستمرارٍ، وما تنقلُه التّجاربُ في ميدانِ التّعلُّمِ والتّلقّي، بدْءًا من وسائلِ الإعلامِ السّمعيّةِ والبصريّةِ ومرورًا بمجتمَعِ النّاسِ، ثمّ مؤسّساتِ الدّولة ومؤسّساتِ المجتمعِ المدنيِّ وفعالياتِه، كالمدرسةِ والجامعةِ والمؤسّساتِ التّربويّةِ والتّعليميّةِ، ثمّ الصّحفِ والمجلاّتِ والنّشراتِ والإعلاناتِ، ومجالِسِ الفكرِ والأدبِ والمُنْتَدَياتِ، والمؤتَمَراتِ والاحتِفالاتِ... وهي تجارِبُ، وإن كانَ مقدارُ الفصيحِ منها هزيلاً بالنّسبةِ إلى ما يتلقّاه المتعلّم باللّهجاتِ الدّارجةِ، فإنّها تزيدُ في تقريبِ اللّهجاتِ بعضِها من بعضٍ لضرورةِ التّفاهمِ بين الأقطارِ العربيّةِ. ولا شكّ أنّ اللّغةَ العربيّةَ الفصحى هي الوشيجةُ التي تشدُّ هذه اللّهجاتِ فيما بينها وتُقرِّبُ بعضَها من بعضٍ. ويُتَصَوَّرُ أن يستمرَّ خطُّ التّقارُبِ بين اللّهجاتِ مع مُستقبَل الأيّامِ، فتختفي كثيرٌ من الألفاظِ والتّراكيبِ العامّيةِ، ويحلُّ محلَّها - بكثرةِ الاستعمالِ والتّداولِ - ألفاظٌ وتراكيبُ عربيّةٌ، ولكنّ شيوعَ العربيّةِ وانتشارَها وحُلولَها محلّ الدّوارِجِ واللّهجاتِ على مدىً واسِعٍ، لا يُعْفي المُؤسّساتِ الرّسميّةَ والاجتماعيّةَ والمَجامِعَ العلميّةَ من دوْرِها في نشرِ هذا التّداولِ العريضِ ؛ فهي مُكَلّفَةٌ بتطويعِ الأوضاعِ اللّغويّةِ وتَقويمِها، واقتِراحِ خُططٍ عِلْميّةٍ وواقعيّةٍ للتّعريبِ الشّاملِ، تقومُ على تنميةِ اللّغةِ داخليًّا، وتهييءِ الأدواتِ والوَسائلِ التّقنيّةِ التي تُؤَهِّلُها لمهمّةِ التّعريبِ والتّمكينِ للعربيّةِ بينَ اللغاتِ الأخرى وتَحسينِ وضعِها التّعبيريّ والتّداوليّ([53]). د- بين العربيّةِ الفُصْحى و"العربيّةِ المُعاصرة": من المعلومِ أنّ استعارةَ اللّغةِ ألفاظًا من لغةٍ أخرى ظاهرةٌ قديمةٌ ومستمرّةٌ لا تنقطِعُ، تُلازِمُ اللّغةَ وتُصاحبُها في تطوّرِها ونموّها، وتنهضُ دليلاً على قدرَتِها على مواكبةِ أحداثِ العصرِ وتطوّرِ العلومِ وانتقالِ الحضاراتِ. ولقد استعارت اللّغةُ العربيّةُ ألفاظًا كثيرةً من لغاتٍ شتّى، وأعارتها ألفاظًا من عندِها. وقد ذكَر الجواليقيُّ في كتابِ "المُعَرَّب"، أنّ اللّغويّينَ الأوائلَ ذكروا أنّ العربَ كثيرًا ما يجترِئونَ على تغييرِ الأسماءِ الأعجميّةِ إذا استعملوها؛ فيُبدِلونَ الحروفَ التي ليست من حروفِهم إلى أقربِها مَخرَجًا، وربّما أبدَلوا ما بعدَ مَخرجِه([54]). لقد عُرِّبت ألفاظٌ مُعجميّةٌ كثيرةٌ ذاتُ أصولٍ يونانيّةٍ وسُرْيانيّةٍ وروميّةٍ وآراميّةٍ وفارسيّةٍ، مثل "الإبريز" و"القِرميد" و"القسْطاس" وغير ذلك... وانتقلت ألفاظٌ عربيّةٌ شتّى إلى لُغاتٍ أعجميّةٍ... ولم يَخْفَ على عُلَماءِ العربيّةِ قديمًا حركةُ النّقلِ اللّغويّةُ التي تقترِضُ بموجبِها لغةٌ من أخرى ألفاظًا معيّنةً، فقد أوردَ الجواليقيّ في مواضعَ كثيرةٍ من كِتابِه، وشهابُ الدّينِ الخفاجِيّ في كتاب "شفاء الغليل فيما في كلامِ العربِ من الدّخيل"، وابنُ منظورٍ في معجمِه "لسان العرب"، كثيرًا من الألفاظِ المستَعارةِ من لغاتٍ مختلفةٍ، وميّزوا بين جانبينِ اثنينِ في النّقلِ: هما الدّخيلُ والمعرّبُ، فأشاروا بلفظِ الدّخيلِ إلى اللّفظِ من حيثُ أصله ومورِده، وبلفظِ المُعَرَّبِ إلى اللّفظِ من حيث نقله ومستَقرّه وخضوعه لمقاييس العربية الصوتيةِ والصّرفيّة، كالإبدالِ والإعلالِ والقلبِ، وغيرِ ذلك من المقاييسِ التي تُعرِّبُ اللّفظَ وتنزعُ عنه عجمتَه وغرابتَه، ممّا يجعلُ اللّفظَ المنقولَ أعجميًّا باعتبارِ الأصلِ عربيًّا باعتبارِ المآلِ. ويهمّنا من هذا التّمييزِ الاعتبارُ الثّاني، وهو صبُّ اللّفظِ في قوالبِ التّعريبِ وإلحاقُه بالألفاظِ التي هي عربيّةٌ بالوضعِ. وهذا النّوعُ من النّقلِ يُغْني العربيّةَ ويرفدُها بألفاظٍ جديدةٍ تمكّنُها من توسيعِ قاعدةِ الدّلالةِ والمعجمِ العربيّينِ، وتُثْبت قدرةَ العربيّةِ على استيعابِ الجديدِ. أمّا حالةُ العربيّةِ اليومَ فإنّها تختلفُ عن حالتِها بالأمسِ فيما يتّصلُ بنقلِ ألفاظِ اللّغاتِ الأخرى؛ فقد تأثّرت العربيّةُ في عصرِنا الحديثِ بجملةٍ من المؤثّراتِ الاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ والثّقافيّةِ، التي عصفت بمعجمِها ونظامِ قواعدِها التّركيبيّةِ والصّرفيّةِ، وجعلتها عرضةً للتّأثّرِ بكلِّ ما يطرأ على المتكلّمين بها، حتّى إنّ كثيرًا من الدّارسين اللّسانيّينَ اليومَ عدّوا حالةَ العربيّةِ الرّاهنةَ حالةً طبيعيّةً أودرجةً من درجاتِ التّطوّرِ الذي بلغتْه، وسَمَّوا العربيّةَ - في حالتِها الرّاهنةِ - بما علقَ بها من تغيّرِ ملَكاتِ المتكلّمين وضعفِ قدراتهم وتأثّرِهم باللّهجاتِ واللّغاتِ الغازيةِ "باللّغةِ العربيّةِ المعاصرةِ"، تمييزًا لها عمّا سمّوه باللّغةِ العربيّة الكلاسيكيّة أو التّقليديّةِ، وكأنّ المقصودَ بالعربيّةِ الفصحى والعربيّةِ المعاصرةِ لغتانِ مختلفتانِ، لكلّ واحدة منهما نظامها وقواعدُها وأصواتُها. فالقولُ بوجود عربيّةٍ فصيحةٍ وأخرى معاصرةٍ أو عامّيّةٍ هو قولٌ بوجودِ "حدوسٍ" متعدّدةٍ أو ملَكاتٍ عربيّةٍ مختلفةٍ، وهذا أمرٌ فيه نظرٌ؛ لأنّ ما يُدعى بالعربيّةِ المعاصرةِ ليس إلاّ استعمالاً مخصوصًا أو"إنجازًا" من "إنجازاتِ" العربيّةِ الفصيحة، والخلافُ بينهما خلافٌ في الإنجازِ والسّليقةُ واحدةٌ في الأصلِ. ويتفاوتُ المتكلّمونَ بالعربيّةِ اليومَ بتفاوتِ المستوياتِ الثّقافيّةِ والعلميّةِ بينهم؛ حيث إنّ المتكلّم العربيّ اليومَ يقتربُ من العربيّةِ الفصحى بقدرِ ارتفاعِ حظّه من الثّقافةِ العربيّةِ، ويبتعدُ عنها بقدرِ انخفاضِ حظّه منها. أمّا الملَكةُ العربيّةُ العامّةُ اليومَ فهي جزءٌ من الملَكةِ العربيّةِ الفصيحةِ ومتفرّعةٌ عنها ومشتقّةٌ منها، وقد تكون منحرفةً عنها بسبب عواملَ عديدةٍ... ويمكن عدُّ بنيةِ الجُملِ التي يُصدرُها المتكلّمُ بالدّارجةِ صورةً منحوتةً من بنيةِ الفصيحةِ، وليس للعربيّةِ المعاصرةِ أوالدّارجةِ ظواهرُ وموادُّ خاصّةٌ بها، ولا يمكن أن يقالَ إنّ لهما معجمًا مشترَكًا، ولكنّ العربيّةَ الفصيحةَ هي التي تشتملُ على المعجمِ وتنفردُ به، وأمّا المعاصرةُ أوالدّوارجُ فإنّها تستمدّ من هذا المعجمِ فتأخذ منه وتدَعُ، بحسبِ التّجربةِ التي يكتسبُها المتكلّمُ العربيّ، وأمّا أصواتُها فإنّها مضمّنَةٌ في أصواتِ الفصيحةِ التي تفوقُها في المكنةِ الصّوتيةِ والعدّةِ التّركيبيّةِ. ولا يمكنُ عدُّ "إهمالِ القواعدِ" دليلاً وشرطًا على قيامِ لغةٍ مستقلّةٍ ؛ فالإهمالُ حالةٌ سالبةٌ لا تغني القواعدَ في شيءٍ. إنّ اللّغةَ العربيّةَ عربيّةٌ واحدةٌ لا عربيّات متعدّدةٌ، فلا ينبغي أن نطلقَ أسماءً من غيرِ مسمَّياتٍ، كالعربيّةِ المعاصرةِ والعربيّةِ السّوريّةِ والعربيّةِ المغربيّةِ والعربيّةِ المصريّةِ؛ إذ ليس هناك أدلّةٌ تجريبيّةٌ تؤيّدُ هذا الحكمَ؛ لأنّ الإنجازاتِ التي تصدر عن المتكلّمين في الوطنِ العربيّ الكبيرِ ليست إلا انحرافاتٍ صوتيّةً وتركيبيّةً ودلاليّةً ومعجميّةً اعترَت العربيّةَ الفصيحةَ، ومن الممكنِ تعديلُها وتصحيحُها لكي تستويَ على حالتِها الفصيحةِ الأولى، وتجريدُها من حالةِ الانحرافِ الذي اعترى جملَها وأصواتَها وصَرفَها ومعجمَها وإعادةُ تأسيسِها على أصلِها العربيّ الفصيحِ. فالإنجازُ اللّغويّ المعاصرُ لم ينبثقْ من عدمٍ، ولكنّه تولّدَ من الملَكةِ العربيّةِ الفصيحةِ نفسِها، هذه الملَكة التي مرّ عليها حينٌ من الدّهرِ وتعرّضت لمؤثّراتٍ مختلفةٍ، ثمّ ظهرت على هيئةٍ جديدةٍ تُدعى "بالعربيّة المعاصرةِ" أوعلى هيئةِ مجموعاتٍ لغويّةٍ مختلفةٍ. وهذه المؤثّراتُ المختلفةُ التي تعرّضت لها العربيّةُ الفصيحةُ في مسيرتِها التّاريخيّةِ وفي رِسالتها التّواصليّةِ والحَضارِيّةِ، أنشأت حالةً من العُزلةِ التي تعاني منها العربيّةُ اليومَ، وهي حالةٌ إيجابيّةٌ تدلّ على قدرةِ العربيّةِ على مواجهةِ مستجدّاتِ العصرِ، ومواكبةِ الأحداثِ، ومقاومةِ عواملِ الطّمسِ والاندثارِ التي تلاحقُ لغاتٍ كثيرةً في العالَم. الهوامش: ----------- ([1]) البَقَرَة، الآية 31. ([2]) العَلَق، الآية 1. ([3]) مسند أحمد، أبوعبد الله أحمد بن حنبل الشّيباني (ت.241)، مؤسسة قرطبة، مصر، ج 2، ص. 172. ([4]) يأرزُ: ينضمُّ ويجتمعُ . ([5]) أبوالحسين القشيري النيسابوري (ت.261)، صحيح مسلم، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1، ص. 131. ([6]) محمّد بن إدريس الشّافعي، الرِّسالة، تح. أحمد محمّد شاكر، دار الفكر، بيروت، ص. 42-50. ([7]) مَجْموعُ فَتاوى شَيْخِ الإِسْلامِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةَ: جَمْع وتَرْتيب: عَبْد الرَّحْمنِ بْن مُحَمَّد بْن قاسِم، مَكْتَبَة الْمَعارِف، الرِّباط، ط. 2، 1401-1981، ص. 32، 255. ([8]) أحمد بن تيمية، اقتضاءُ الصّراطِ المستقيم، تصحيح وتعليق: محمّد عليّ الصّابوني، مطابع المجد التّجاريّة، ص. 463. ([9]) محمود محمّد شاكر، أباطيل وأسمار، مط. المدني، القاهرة، ط.2، 1972، صص. 237-240. ([10]) مصطفى صادق الرّافعي، تحت راية القرآن، صحّح أصولَه محمّد سعيد العريان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.7، 1394-1974، ص. 26. ([11]) انظر في هذا الموضوع: علي عبد الواحد وافي، اللّغة والمجتمع، مط. عيسى بابي الحلبي وشركاه، دار إحياء الكتب العربية، ط.2، 1370-1951، ص. 10. ([12]) تراجعت قدُراتُه تحت وطأةِ الاستعمارِ الذي حاربَ العربيَّةَ حَرْبًا ضروسًا، وأحلَّ الحرفَ اللاّتينيَّ محلَّ الحرفِ العربيِّ وسعى إلى القضاءِ على جلِّ المراكزِ الإسلاميّةِ من كتاتيبَ ومدارسَ قرآنيّةٍ وزوايا ومساجدَ، وأصبح استعمالُ العربيّةِ ممنوعًا بالقوّةِ في كلّ مرافقِ الحياةِ، بما فيها المدارس ومناهج التّعليمِ. انظر: الفرنكفونيّة والسّياسة اللّغويّة والتّعليميّة الفرنسيّة بالمغرب، الأستاذ الدّكتور عبد العلي الودغيري، الشّركة المغربية للطّباعة والنّشر، الرّباط، ط.1، 1993، ص. 73. ([13]) يتّخذُ صراعُ العربيّةِ مع غيرِها من اللّغاتِ واللّهجاتِ، طابعينِ اثنينِ: طابع الازدواجيّة وذلك في صراعِها مع اللّهجاتِ المحلّيةِ والدّوارِجِ التي تُساكنُها، وطابع الثّنائيّةِ وذلك في صراعِها مع لغاتٍ أجنبيّةٍ أخرى دخلت مع دخولِ الاستعمارِ وفُرِضت بقوّةِ الحديدِ والنّار. انظر في بيان الفرق بين الازدواجية والثّنائيّة: (المقارنة والتّخطيط في البحث اللّساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنّشر، البيضاء، ط.1، 1998، ص.151). ([14]) أمين الخولي، مُشْكِلاتُ حياتِنا اليوميّة، الهيئة المصرية العامّة للكتاب،1987، ص. 8. ([15]) صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت.256)، تح. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، ط. 3، 1407-1987، ج 1، ص. 50. ([16]) أفضّلُ استعمالَ "اللِّقانةِ" بدلاً من "البيداغوجيا"، وهواصطلاحٌ من اقتِراحِ الأستاذِ اللّغويِّ الكبيرِ: أحمد الأخضر غزال، انظر في هذا الشّأن حوارًا أجرته معه مجلّةُ "الموقف" المغربيّة تحت عنوانِ «أحمد الأخضر غزال وتجربة المغرب الخاصّة في التّعريب»، مجلة "الموقف" عدد 3، محرم 1408/ شتنبر 1987. ([17]) وهذا ما حذَّرَ منه صامويل هنتنغتون في كتابِه "صدام الحضارات" وفرنسيس فوكوياما في كتابِه "نهاية التّاريخ". انظر: الخروج من التّيه، دراسة في سلطةِ النّصّ، سلسلة: عالَم المعرفة، عدد 298، رمضان 1424/ نوفمبر 2003، إصدار: المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكويت، ص. 9. ([18]) لا شكّ أن العامّيّةَ أساءت إذ عبثت بالقُيودِ اللّغويّة، فبات من المستحيلِ وضعُ قواعدَ محكَمَةٍ لصرفِها ونحوِها ولكتابتِها ؛ فهي في الكثيرِ من تعابيرِها تكادُ تكونُ لغةَ اختزالٍ، والعامّيّة العربيّةُ "لُغاتٌ" عدّةٌ لا "لغة" واحدة. هذا وقد وُجدَ من المثقّفين والكُتّابِ والباحثين من دافعَ عن العامّيّةِ والْتَمَسَ لها الأعذارَ وحمّلَ الفُصْحى تبِعاتِ العامّيّاتِ وأوزارَها، من أمثال ميخائيل نعيمة، لنستمع إلى مقالَتِه في الموضوع: « غيرَ أنّ تفلُّت العامّيّةِ من القيودِ لا يجبُ أن يُعمِيَنا عمّا في قُيودِ الفصحى من الإرهاقِ، فهناك قواعدُ كثيرةٌ قد يكون أنّها كانت ضروريّةً فيما مضى، أمّا اليومَ فقد أصبحت أَحاجِيَ في استطاعتِنا نبذُها من غيرِ أن نخسرَ اللّغةَ أونخسرَ شيئًا بل على العكسِ، فللُّغة ولنا في نبذِها أو تعديلِها خيرٌ عميمٌ، واذكرْ على سبيلِ المثالِ أحرفَ النّصبِ والجزمِ، والنِّداءِ والتّمنّي، والإعلالِ والإدغامِ، وكان وأخواتها، وإنّ وأخواتها، والهمزةَ وعينَ المضارِع، والأعدادَ المركَّبةَ، والممنوعَ من الصّرفِ ... ولا أزيدُ، فالمجال يتّسعُ للتّمادي في البحثِ والتّحليلِ» (بين العامّيّة والفُصحى، الأعمال الكامِلة لميخائيل نعيمه، دار العلم للملايين، بيروت، ط.1، مارس 1973، ج 7، ص. 356-359). ([19]) عائشة عبد الرّحمن، لُغتُنا والحياة، دار المعارف بمصر، 1969، ص. 187. ([20]) لغتنا والحياة، المرجع السابق، ص. 93. ([21]) انظر ذلك في كتاب: "Linguistique et colonialisme" للكاتب الفرنسي Louis-jean Calvet سنة 1974، وقد ترجم فصلاً منه إلى العربيّةِ الأستاذ الدّكتور عبد العليّ الودغيري، مع مجموعةٍ من المقالات ضمن كتابِه: "الفرنكفونيّة والسّياسةُ اللّغويّةُ والتّعليميّةُ بالمغرب"، (ص. 15)، الذي ضمّ مجموعةً من المقالات التي عرّبَها وقدّم لها وعلّقَ عليها. والكتاب من منشوراتِ العلَم، السّلسلة الجديدة-7، الشّركة المغربيّة للطّباعة والنّشر، الرّباط، ط.1، 1993م. ([22]) هناك وثيقةٌ رسميّةٌ توضِحُ السّياسةَ اللّغويّةَ الفرنسيّةَ التي أريدَ لها أن تُطَبَّقَ بإفريقيا الغربيّة، وهي دوريّةٌ صدرت بتاريخ 8 ماي 1911 بتوقيع حاكم فرنسا العامّ بإفريقيا الغربيّة W.Ponty، من 1908 إلى 1915، ثمّ أصدر بعد ذلك مرسومًا بتطبيقِ سياسةِ منع استعمالِ اللّغةِ العربيّة في المحاكمِ الإسلاميّة ببعضِ مدن السّنيغال الكبرى. وهناك وثيقةٌ أخرى هي دوريّة أصدرَها الماريشال ليوطي في 16 يونيو 1921، حول منع استعمال اللّغةِ العربيّة بالمغربِ الأقصى، ووثيقة بونكارير Bonnecarrère مفوّض فرنسا في الطّوغو، في 26 شتنبر 1922 التي دعا فيها إلى "فرْنَسَة الطّوغو"... انظر: الفرنكفونيّة والسّياسةُ اللّغويّةُ والتّعليميّةُ بالمغرب" نصوص حول منع استعمال العربية في إفريقيا، ص. 73-88. ([23]) انظر قصّةَ هذا الرّجلِ وحقيقته العلميّة، في ما كتبه عنه الكاتب الكبير الأستاذ محمود محمّد شاكر في كتابه: أباطيل وأسمار، ص.87 وما بعدها. ([24]) انظر: نحوعربية ميسَّرة، ص. 13، وص. 141. ([25]) أشار الأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار إلى عشراتِ الكتب التي تُرجِمت في القرنِ التّاسعِ عشرَ من اللّغاتِ الأوربّيّة إلى العربيّة، ولم يشكُ أحدٌ من المترجِمينَ ممّا شكا منه سلامة موسى وأنيس فريحة وأمثالُهما. انظر فصل: قُصور العربيّة عن المعارف الإنسانيّة [الزّحف على لغة القرآن، ص. 94 - ...]، دار العلم للملايين، بيروت، ط.1، 1385-1965. ([26]) عبد العلي الودغيري، الفرنكفونيّة والسّياسةُ اللغويّةُ والتّعليميّة بالمغرب، مرجع سابق، صص. 53-55. ([27]) انظر: صبحي الصّالح، دراسات في فقه اللّغة، دار العلم للملايين، ط.6، 1976، 45. ([28]) انظر التّعليق على هذا التّقسيم العنصري، في ما ذكره Morris Houis في كتابِه "Anthropologie linguistique de l'Afrique noire"، وأوردَ النَّصَّ Louis-jean Calvet في كتابه "Linguistique et colonialisme". انظر ترجمة فصلٍ من هذا الكتاب، في "الفرنكفونيّة والسّياسة اللّغوية والتّعليميّة الفرنسيّة بالمغرب"، المرجع السابق، ص. 57 وما بعدها. ([29]) التّغريبُ هنا بمعنييْه المعروفين: "الغُرْبَة"، و"شَدُّ الأمّةِ إلى الغَرْبِ" لاقتفاءِ أثرِه . ([30]) الخروج من التّيه، دراسة في سلطة النّصّ، مرجع سابق، ص. 9. ([31]) عبد الكبير الخطيبي، المغرب العربي وقضايا الحداثة، ترجمة لجنة ترجمة أعمال عبد الكبير الخطيبي، الشّركة المغربية للناشرين المتّحِدين، الرباط، 1993، ص. 7-11. ([32]) محمّد عابد الجابري، التّراثُ والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، ط.1، سبتمبر 1991، صص. 15-19. ([33]) طه عبد الرحمن، سؤالُ الأخلاق، مساهمة في النّقد الأخلاقي للحداثة الغربية، نشر المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط.1، 2000. ([34]) محمّد رشاد الحمزاوي، العربيّة والحداثة، دار الغرب الإسلامي، ط.2، 1986، ص. 11. ([35]) أديب مروة، الصّحافة العربية نشأتها وتطوّرها، بيروت، 1961، ص. 111. ([36]) تحدّثَ الأستاذ عبّاس محمود العقّاد عن قيمةِ الحركاتِ الإعرابيّةِ في بيانِ معاني الجملِ وتمييزِ بنيتِها، فقالَ: «لقد كانَ للحركاتِ في اللّغةِ العربيّةِ شأنٌ لا نُحيطُ بجميعِ دلالاتِه ومعانيه، ولكنّنا نلحظُه في الإعرابِ وفي غيرِ الإعرابِ، ونلحظه في أوّلِ الكلمةِ ووسطِها كما نلحظه في نهايتِها واتّصالِها بغيرِها، ونرى أنّ الاستغناءَ عنه يُلْجِئُنا إلى تغيرِ بنيةِ الجملةِ كلّها كما تتغيّر بنيتُها أحيانًا من فعليّةٍ إلى اسميّةٍ... ويحدثُ دائمًا عند إهمالِ الإعرابِ أن يتغيّرَ بناءُ الجملةِ من فعليّةٍ إلى اسميّةٍ ؛ فاللّغاتُ الأوربّيّةُ لا تعرِفُ = = ولا تعرِفُ الفعليّةَ كذلك إلاّ في بعضِ الحالاتِ النّادرةِ ... وهذه الجملةُ الاسميّةُ تظهرُ في اللّغةِ العربيّةِ نفسِها على ألسنةِ العامّةِ الذينَ يُهْمِلونَ الإعرابَ، ومن هذا يتّضحُ لنا أنّ الإعرابَ له دلالةٌ مرتبطةٌ بتركيبِ الجملةِ في اللّغةِ، بحيثُ تحتاجُ إلى تركيبٍ ينوبُ عن الإعرابِ ». (عبّاس محمود العقّاد، بين الكتب والنّاس، دار الفكر، القاهرة، 1398-1978، صص. 288-290). ([37]) تعتبرُ الدّارِجةُ المغربيّةُ مثالاً على ذلك، فهي مزيجُ لهجاتٍ ولُغاتٍ مترسّبةٍ، كالأمازيغيّةِ، وبعضِ اللّغاتِ الأوربيّةِ والشّرقيّةِ القديمةِ، ويرجّحُ الباحثونَ أن تكونَ طفولةُ الدّارجةِ المغربيّة راجعةً إلى العهدِ الفبنيقيّ عندما دخل الكنعانيّونَ العربُ إلى المغرب دخولاً رسميّا عامَ 480 ق.م وامتزجوا بالبربر فتكوّنت في شمالِ إفريقيا لغة تسمّى البونيقيّة، انظر في ذلك: عبد العزيز بنعبد الله، مظاهر الحضارة المغربية، صص. 57-59، نقلاً عن: [الحركة اللّغويّة بالمغرب الأقصى بين الفتح الإسلامي والغزوالكولونيالي"، ص. 150] 1، تفاعل الألسن"، للأستاذ ميلود توري، مط.آنفوبرنت، فاس، ط.1، 2001. ولا ننسى هنا أثر الرحلات الوافدةِ إلى المغرب والهجرات المتعاقبة إلى أرضه، كأسرة بني صالح وأسرة الأدارسة، في الفتوحاتِ الأولى، والكثير من الأندلسيين في العصر المرابطي الذي عرفَ انفتاحًا واسعًا على الأندلس، فأخذت الدّارجةُ المغربيّة تنتشر على نطاقٍ واسعٍ في مناحي الحياةِ الاجتماعيّة والثّقافيّةِ في الحواضر المغربيةِ، إلى حدّ أنّها تمكّنت من أن تغزُو اللغةَ العربيّةَ الفصحى وتُلابِسَها في بعضِ المؤلّفاتِ على عهدِ الموحّدينَ، كما هو الشأن في كتابِ "أخبارِ المهدي بن تومرت" للبيذق، الذي وردت فيه كثيرٌ من الألفاظِ العامّيّةِ، وكتاب "المعجب" لعبد الواحد المرّاكشي وغيرهما ... فنتج عن تفاعلِ العربيةِ واللّهجاتِ الأمازيغيّةِ واللّهجاتِ الوافدةِ على المغربِ دوارِجُ عامّيةٌ انتشرت بمناطقَ كثيرةٍ من المغربِ وتميّزت كلّ واحدةٍ منها بصفاتٍ لغويّةٍ وبمظاهرَ صوتيّةٍ ومعجميةٍ ودلاليّةٍ، ولكنّها على ما فيها من فروقٍ ومميّزاتٍ تجتمعُ في طابعِها العربيّ الذي يجعلُها تمتّ إلى العربيّةِ الفصحى بأكثرَ من صلةٍ. انظر: [الحركة اللّغويّة بالمغرب الأقصى، ص. 150-159]. ([38]) Adamczewski, Le montage d'une grammaire seconde. in: Langage, Sept. 1975, n°39 p:31-37. ([39]) Jean-Yves Pollock, "Langage et cognition. Introduction au programme minimaliste de la grammaire générative". Collection Psychologie et sciences de la pensée, P.U.F, 1997. ([40]) الأعراف، الآية 138. ([41]) انظر: الأعمال الكاملة لميخائيل نعيمه، بين العامّية والفصحى، ج 7، ص. 359. ([42]) إعجاز القرآن والبلاغة النّبويّة، للأستاذ مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله، مَجْموعةُ مُصْطَفى صادِق الرّافِعِيّ، صَحَّحَهُ وضَبَطَ كَلِمَهُ وحَقَّقَ أُصولَهُ وعَلَّقَ بَعْضَ حَواشيهِ وقَدَّمَ لَهُ: الأُسْتاذُ مُحَمَّد سَعيد الْعرْيان. دار الْكِتاب الْعَرَبِيّ، بَيْروت، ط. 2، 1420-1999، صص.91-92. وقد رَجعَ الأستاذ مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله سببَ حفظِ العربيّةِ إلى استقرارِها في العقلِ والشّعورِ النّفسيّ للمتكلّمين، الذي هو أمرٌ موصولٌ بالقرآنِ الكريمِ، وهو أمر بيدِ الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحدٍ، ولذلك بقي محفوظًا ... ([43]) إعجاز القرآن والبلاغة النّبويّة، المصدر السابق، صص. 90-91. ([44]) عن كتابِ: أحمد عبد الغفور عطّار، الزّحف على لغةِ القرآن، ص. 225. ([45]) انظر التّفصيل في: الزّحف على لغة القرآن، دعاة العامّيّة يُحاربون الفصحى، ص. 47 وما بعدها. ([46]) Linguistique historique et Linguistique générale, Tome 1 (1983), Genève, éd. Slatkine, Paris. ([47]) منذر عياشي، «اللّغة والتّطوّر في الدّراساتِ اللّسانيّة»، مجلة الفيصل. ([48]) ابنِ فارس اللّغويّ، الصّاحبيّ في فقه اللّغة، ص. 78. ([49]) أحمد تيمور باشا، لهجات العرب، تقديم إبراهيم مدكور، سلسلة المكتبة الثّقافيّة، ع، 290، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1393-1973. ([50]) انظر في الفرقِ بين "الازدواجيةِ" و"الثّنائيّة" كتابَ: المقارنة والتّخطيط في البحث اللّساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنّشر، البيضاء-المغرب، ط.1، 1998، صص. 151-154، ([51]) منذر عياشي، «اللّغة والتّطوّر في الدّراساتِ اللّسانيّة»، مجلّة الفيصل. ([52]) «ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزَّتْ قدرته مَخَضه وألقى زُبْدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام؛ فما من خطيب يقاومه إلا نكَص متفكك الرجل وما من مصقِع يُناهزه إلا رجع فارغ السَّجْل» (محمود بن عمر الزّمخشري، الفائق، تح. علي محمّد البجاوي ومحمّد أبوالفضل إبراهيم، دار المعرفة بيروت، ط.2. ج 1، ص. 11). ([53]) انظر في الموضوع: الآراء الوجيهة التي أوردَها د. عبد القادر الفاسي الفهري، حول خطط التّطويع الوظيفيّة والتّطوّريّة والقالبيّة، في كتابه: "المقارنة والتّخطيط في البحث اللّساني العربيّ"، ص. 157 وما بعدها. ([54]) الجواليقي، المُعَرَّب، ص. 6. عن موقع مجلة التاريخ العربي |
|
#2
|
|||
|
|||
|
.
أشكرك أخي على هذا الموضوع الممـيز,,, استفدت كثير منه وفقك الله وبارك فيك ؛ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
مشكور والله يعطيك الف عافيه .
|
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
link
تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية





